أزمة نص؟ أم أزمة نقد؟الباب: مقالات الكتاب
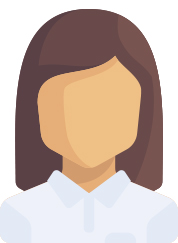 | أ. د. أميرة علي الزهراني أستاذ الأدب والنقد الحديث |

مدخـــــل:
أزمة نص؟! أم أزمة نقد؟! أم إشكالية منهج؟!
تناقش هذه الدراسة ووفق اتجاه نقدي ينضوي تحت مظلة "نقد النقد" المشكلة القائمة بين النقد الأدبي اليوم، والمنتج الرديء من الأعمال الأدبية، منطلقًا من التساؤلات التالية:
- هل النقد هو المسؤول، فعلاً، عن تنامي الرديء من النصوص الأدبية؟
- هل هي أزمة نص، أم أزمة ناقد، أم إشكالية منهج يحوم في دراسته حول العمل ولا يغامر بالولوج إلى أدبية النص للكشف عن جمالياته وقبحه؟!
- هل وظيفة الأدب، والقدرة على الاستمتاع به، تتغير بتغير الحياة؟!
هل الناقد مطالب بأداء الدور الرسولي التعليمي الوعظي في نقده لكل ما يصدر من أعمال أدبية، بغض النظر عن مدى استمتاعه بالعمل؟!
- ما الجدوى من نقد الأعمال الرديئة ؟!
- ما موقف النقد اليوم من الالتفات إلى العمل الرديء؟!
- هل الإدانة التي يتعرض لها النقّاد من قِبل الكتّاب، الجدد على وجه الخصوص، في الإهمال الذي تلقاه أعمالهم تبدو منطقية ومبررة؟!
- لماذا تتحول صيحات الكتّاب في المطالبة بالالتفات إلى أعمالهم إلى هجوم مضاد انفعالي ناحية الناقد، في حال كشفه عن رداءة العمل؟!
- ما مفهوم الجمال والقبح في العمل الفني؟!
الجدير بالذكر أن البحث سيتخذ من آراء بعض الروائيين السعوديين، تجاه النقد، نموذجًا للإدانة التي يمكن أن يتعرض لها الناقد.
الحياة الجديدة ووظيفة الأدب
من المعلوم أن علاقة القارئ بالأعمال الأدبية قد تتعرض إلى تحول وتغير بتغير الزمان، وتغير وعي الإنسان، وحاجته من النصوص، وتناميه معرفيًا، وتبدله نفسيًا بفعل ظروف العصر، وما طرأ عليه من سيادة عجلة التقنية، بما يكتنفها من سرعة. "ذلك أن أشكال التعبير القديمة كانت متلائمة مع نوعية الوظيفة التي كانت منوطة بها"(1). لكن مع هذا ظلت كثير من النصوص لا تبرح التقاليد القديمة في إنتاج الأدب، غير مدركة أن "مقتضيات الحياة الجديدة جعلت أشكال التعبير القديمة، وخاصة تلك التي رسمت حدودها البلاغة العربية، غير قادرة على تلبية العمق المعرفي والوجداني للإنسان العربي الحديث الذي تشبع بالفلسفات واستوعب التاريخ الإنساني والرصيد الثقافي والأدبي والعالمي"(2). لاسيما تلك النصوص التي لا تتجاوز، في الغالب، حدود المتعة وتزجية الفراغ، ووفق ذائقة قارئ قديم، وظروف قديمة.
إن تغير وظيفة الأدب هذه، ضاعفت من حجم الدور الذي يلعبه النقد في الأوساط الأدبية، فالمسألة لم تعد مجرد قراءة النص من الخارج، أو إرشاد القارئ والكاتب إلى البديل المؤثر البليغ في الجمل والصياغة والتراكيب والأساليب، وتفسير الغامض المبهم. وإن كانت هذه الوظيفة مازالت صالحة حتى اليوم، فهي أليق بالناشئة المبتدئين في التعليم وفق الأسلوب المدرس التقليدي، أما ما يتوجه إلى القارئ اليوم، فإن مهمة النقد بدت أكثر إجهاداً وأكثر تسلحًا في أدوات النقد، منطلقة من وعي الناقد بحاجات القارئ الجديد من النصوص الأدبية.
إن واحدة من أسباب تراجع جاذبية النقد المنشور في الصحف والملاحق الثقافية هي في استمرارية الناقد على ممارسة الأسلوب التقليدي المدرسي نفسه في نقده للأعمال. على سبيل المثال، حين يشير ناقد ما، خلال نقده، إلى أن الأديب يخاطب في نصه الوطن، أو الحبيبة، أو هو يتذكر الماضي... فأنت تهبط بمستوى القارئ بكل ما يحمله من تركة ثقافية ومعرفية واستعلاء في الذائقة إلى أدنى درجات الاستيعاب البسيط للنص. لأننا؛ أنا وأنت وهو ندرك ذلك المعنى تلقائيًا دون الحاجة إلى دعم وسيط نقدي. مهمة الناقد أعمق وأشق وأميز من ذلك بكثير، وعدم استيعاب وظيفة الأدب اليوم تتخلق منها مشكلة لدى المبدع والناقد على السواء.
طفرة في السرد.. تراجع في النقد
لقد برزت قبل سنوات، ومع تزايد دور النشر وموجة الكتب الإلكترونية، العديد من الأعمال الأدبية لاسيما الروائية، كانت في أكثرها روايات استهلاكية، سريعة، باهتة، لا تخلّد أثرًا ولا تقدم تجربة عميقة جديرة بالقراءة والتأمل. "غير أن نمط الرواية الاستهلاكية، وهو لاشك، إفراز لنمط الحياة الاستهلاكية وأساسها تأثير وسائل الاتصال، قد انتشر في الحياة الثقافية العربية بأشكال متعددة. كان الروائي أو القاص العربي معزولاً عن وسائل الاتصال بالجماهير، أو «هوجة» مخاطبة الجماهير مباشرة، لأن وسائل الاتصال بالجماهير نفسها لم تكن لها مثل هذه السلطة المتفاقمة التي نراها عليها اليوم، ولأن الجماهير نفسها لم تكن موضع الحفاوة والتقدير والاهتمام التي يجري الحرص عليها اليوم، فأخلص الروائي أو القاص العربي من قبل لفنّه، واستغرق في صومعة أفكاره"(3). في الوقت الذي غدا الكاتب فيه اليوم يكتب وعين على الورق وأخرى على الجماهير والحفاوة التي يمني نفسه بها.
هناك استعجال في كتابة الرواية تحديدًا، واندفاع مشوب بالتوق الشديد للشهرة خاصة مع توفر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلامي، ربما حرّضه لاختزال جهد كتابة الرواية في اصطياد عنوان برّاق تسويقي يشتغل على التماس مع مقدسات أو أعراف أو ثوابت تستفز الجمهور لاقتناء الرواية، وبالتالي تداولها في الأوساط الإعلامية(4).
بالنظر، على سبيل المثال، إلى الإنتاج الروائي فقط في المملكة العربية السعودية، سنجد أنه خلال الفترة المحددة (2001 – 2006) وصل هذا الإنتاج إلى مائتين وست روايات. وقد تصاعد الإنتاج الروائي حتى بلغ ذروته العام الأخير 2006 حيث صدر في هذا العام، وحده، اثنان وخمسون رواية، أي ما يقارب رواية كل أسبوع. كانت أكثرت الروايات من إنتاج الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرينيات. ولأول مرة يحدث أن تقف الرواية النسائية في مواجهة موازية مع الرواية التي كتبها الرجل من حيث الإنتاج (خمس وعشرون رواية للمرأة مقابل سبع وعشرين رواية للرجل)(5). مجمل تلك الروايات تحركت مضامينها في كشف المسكوت عنه، وخرق التابوهات، ومساءلة لأيديولوجيا القهر، وتعرية المجتمع. فضلاً عن استمرار كتابة المرأة رواياتها، كسابقتها، ضمن إطار ما يعرف بـ«الكتابة النسوية» Feminist Writing 6. أي الكتابة من وجهة نظر نسوية، وعن التجربة الخاصة بهنّ وعن قضيتهنّ اللائي يمثلنها، ويرين أنهن الأقدر على تجسيدها روائيًا. وهو شأن خنق إبداع المرأة في خندق ضيّق تغمرها فيه القضايا المستهلكة، وفوّت عليها فرصًا لتناول موضوعات إنسانية ووجودية أرحب.
مجمل روايات تلك الفترة يمكن تصنيفها بأنها "خطاب إيديولوجي" أكثر من كونها رواية فنية، فالعديد منها تحول إلى منابر ومرافعات يحاكم فيها الكاتب المجتمع، وكثير منها لا يتجاوز حدود الثرثرة، اتبع الروائي فيها أسلوب الحكواتي القديم، فنقل الحكايات والدردشات البسيطة الساذجة التي تدار في المجالس على ورق فاخر وبأغلفة جميلة، وعناوين مغوية. لكنها تفتقد للقيمة الفنية الجمالية للرواية.
وإذا كان وراء تلك الطفرة في الإنتاج الروائي على مستوى المنطقة العربية بشكل عام، مبررات، ليس موضوع دراستنا الحديث عنها ومناقشتها، إلا أن ما ستركز عليه الدراسة، تلك الإدانة التي لحقت بالناقد، بوصفه هو السبب وراء تفشي هذه الظاهرة، من خلال مجاملته بعض الروايات الباهتة، والترويج لها بتناولها على صفحات الجرائد والمجلات، أو من خلال "الصمت" الذي لحق ببعض النقاد إزاء ما ينتج سنويًا من روايات رديئة، تزخر بها الساحة ومعارض الكتب.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل الناقد هو المسؤول فعليًا عن تنامي هذه الظاهرة؟! وعن التخلي، عمّا يراه الآخرون مسؤوليته، في إرشاد الكتّاب، الجدد منهم على وجه الخصوص، للطريقة المثلى في الكتابة الفنية ؟! هل الناقد مضطر لقراءة عملٍ رديء ؟!!
الصائحون بوجود أزمة في النقد!!
أزمة غياب "النقد" للأعمال السردية، على وجه الخصوص، من أبرز الإدانات التي تُلصق بالنقّاد الذين يتهمون، في الغالب، بانغماسهم في الاشتغال على النظريات الفنية الأجنبية المستوردة، والاستشهاد، خلال تطبيق النظرية، بأعمال كتّاب عالميين. أو بالقديم المقدس، من وجهة نظر بعضهم، دون الالتفات إلى ما يطرح في الساحة المحلية، ومتابعة ما يُنتج بالدراسة والتحليل. بغض النظر عن جودته ورداءته.
لا تكاد تعثر على لقاء مع روائي أو روائية شابة إلا وتجده يلمح بأسى إلى مسألة التهميش تلك. والحقيقة أن هذه الأزمة ليست جديدة، إنما هي قديمة منذ الإرهاصات الأولى لنشأة الأدب في الوطن العربي، وبدايات انتشار الصحافة(7). وغياب النقد في تلك الفترة، كان ناتجًا عن عدم شيوع النقد الأدبي كتخصص أكاديمي شائع ومنشور في الصحف، فضلاً عن غياب الوعي بأهميته، ربما كان ذلك من أبرز العوامل التي دفعت بالكتَّاب السعوديين، على وجه الخصوص، آنذاك، إلى تقديم أعمالهم إلى الكتّاب في الوطن العربي لكتابة مقدمات، تتضمن رؤيتهم عن العمل(8). لكن المسألة الآن تخلصت من معضلة شح عدد النقاد، أو غيرها من اعتلالات تكتنفها، عادة، البدايات.
الجدير بالذكر أن النقاد أنفسهم يدركون تلك الأزمة تمامًا، وهي ليست محلية على الإطلاق، كما أنها ليست مقرونة، فقط، بالتجارب السردية، إنما بالأدب عمومًا "إننا نكاد لا نجد ناقدًا واحدًا أنجز خطابًا نقديًا أو مشروعًا نقديًا أو تنظيرًا نقديًا لم يخض في مناقشة "أزمة النقد الأدبي" وكأنه لا يجد تمهيدًا لعمله إلا أن يسفّه النقد الذي يسبقه أو يعاصره وينتقص منه، متعاليًا عليه بعد أن يكيل له التهمة بعد التهمة، وكأن الوقوف عند الوضع النقدي السائد، بانتقاده وتوضيح عيوبه وقصوره، يوهم بأنه خطاب تنظيري للنقد"(9).
الحقيقة أن حضور تهم موجهة للنقد مثل: غياب الحركة النقدية القائمة على الحوار، والانقطاع عن متابعة الإبداع الأدبي، وغياب التواصل مع القارئ، وغياب المفاهيم النقدية، وتخلف مناهج النقد في التعامل مع الظاهرة الأدبية ... وغيرها من تهم تعكس مجملها الفوضى التي يعيشها النقد في الواقع الأدبي العربي، وذلك بسبب غياب الوعي بطبيعة النقد ودوره(10). وقد لا تكون تلك الفوضى خاصة، فقط، بحقل النقد الأدبي، بل بمجل أنظمة الواقع العربي بمؤسساته، وجهاته المتعددة. نابعة عن تخلف ثقافة الحوار، البنية الأساسية التي ينهض عليها النقد، والإصلاح.
إن أغلب تلك الآراء، وغيرها، تنحاز إلى جانب مهمة الناقد، التي يراها أصحاب متن التعليم هي "خدمة القارئ" أو شعار "تقريب الأدب إلى القارئ" أي مساعدته في فهم العمل الذي يقوم الناقد بتحليله، وبالتالي يمكّن الجمهور من التواصل مع العمل الأدبي، وينمي حساسيته، ويثري تجربته الإنسانية، ويسهم في يقظة الوعي لديه، وتنمية ذائقته الفنية(11). إلى جانب وظيفة أخرى يتقمص فيها الناقد دور "المعلم" أو المرشد بحيث يضطلع بمهمة التركيز "على مجموعة من المبادئ تقوم بإقدار المتأدب على فهم نظرية الأدب وإرشاد الأديب من خلال نظرات منهجية محددة إلى اختيار طريق من طرق عدة أو اتباع أسلوب من أساليب متشابكة"(12). إذا كانت مهمة الناقد كذلك، "أن يزيد في الفهم والتذوق، أن يمكّن القارئ من أن يرى ويتذوق الأثر الفني كما هو حقًا. أي أن يعلّمه كيف يقرؤه"(13). على أساس أن العناية بالجوانب النظرية للنقد دون وجود ممارسة نقدية فعلية هو من قبيل وضع العربة أمام الحصان(14). إن الممارسة الفعلية للنقد الجاد الذي مكنته الكشف عن جماليات النص وتحليل لغة النص للحكم على أدبيته هو أحوج ما يكون إليه المشهد الثقافي.
مهما يكن من جدل حول تلك المسألة، إلا أن صرخات الكتَّاب بغياب النقد تقابلها، في الغالب، مقاومة من جهتهم للنقد الذي لا يمتدح أعمالهم. أما تشددهم في المطالبة بنزاهة النقد وموضوعيته فمازالوا يستبقونها، ويتشددون في ضرورة توفرها، فقط، مع أعمال غيرهم، وهم بذلك يبرهنون على أن "الصائحين بوجود أزمة في النقد الأدبي هم أضيق الناس صدرًا بالنقد عادة. وهم حين يتوقعون انفراج الأزمة، فإنما يتوقعون أن تُستنفر الأقلام، تمتدح وتقرظ، لا تنتقد ولا تقيم"(15). لقد آثروا استمرار موجة المدائح والمبالغة في الإطراء التي كان يلحقها بعض النقد العربي بالأعمال المحلية المتواضعة آنذاك، الأمر الذي أوصلوا فيه أعمال أدبية محلية متواضعة إلى مصاف العالمية(16). في فترة مبكرة كان الكتّاب السعوديون أحوج ما يكون للاعتراف بأدبهم الناشئ، وليست الدراسة النقدية الصارمة المنهجية التي قد لا يحتملها، كثير من إنتاجهم الأدبي المتواضع آنذاك.
من الملاحظ أن هناك إدانة رائجة للنقد بأنه المسؤول عن شيوع الأعمال السردية الرديئة، لافتقاد النقد الموضوعي الذي يفرز القبيح من الجميل(17). كما أن هناك مطالبات من الروائيين بضرورة التفات النّقاد لأعمالهم، فهم يرون، غالبًا، في النقد المنشور المادح لأعمالهم قناة باهظة للشهرة والترويج لذواتهم، وتحقيق مطامح لهم تتآزر غالباً ومستوى حماسهم الشاب في نيل الحضور والدعوات، والتمثيل الخارجي ومعانقة صورهم صفحات الجرائد والمجلات(18). لكن هؤلاء الكتّاب، يجابهون، في الوقت نفسه، أي نقد يرونه، من وجهة نظرهم، معادياً لعملهم.
ويبدو أن هذه المجابهة، في حقيقة الأمر، عالمية وليست محلية، فالكاتب أرسكين كالدويل في أول مجموعة قصصية له بعنوان "الأرض الأمريكية" (1931) وتناولها في الصحف بالنقد الذي وصفه بأنه "المعادي" يقول: "ولم تكن الملاحظات على كتابي فريدة في هذا المجال. لقد وجدت عندما قرأت المراجعات النقدية لكتب المؤلفين الآخرين أن المعاملة المتكبرة هي النمط السائد والشائع. وبدا أن هناك دليلاً منطقيًا – برغم كل شيء – يثبت وجود شيء من الحقيقة في الاعتقاد الذي يشير إلى أن العديد من النقاد الأدبيين ينضوون تحت فئة العاشق العنين أو المؤلف الفاشل"(19).
إن المرور على سياقات الإدانة السابقة، وما تخلفه من ردود فعل وتعليقات متناقضة من جهة الكتَّاب، في مقدورها إثبات أن الأزمة، أو الظاهرة، إن أمكن تسميتها بذلك، لها صلة بالناقد وبالكاتب على السواء، فضلاً عن العمل المنقود.
هل الناقد مضطر لنقد النص الردي؟!
الطبيب يجد حرفته في الجسم العليل، لا يمكن أن يكون طبيبًا فعليًا ما لم يبرهن على قدرته الطبية في تشخيص المرض للجسم المريض وتقدير العلاج الفعّال. المهندس والكهربائي كذلك، إنشاء المباني والكهرباء وإصلاح الأعطال هما لب اشتغالهما. الشأن سواء، في مجمل الحِرف التي تتكئ قدرة المتخصص فيها على مهارته في تصحيح الخطأ وإزالة العطب. لكن ماذا عن النقد الأدبي بوصفه حرفة؟!! هل على الناقد أن يتعاطى مع النصوص المعطوبة، كما الطبيب مع الأجسام العليلة، حتى يبرز براعة أدواته النقدية؟!! هل الناقد مضطر لقراءة عمل رديء تحت المبررات، التي أشارت إليها الدراسة، وهي إرشاد كاتب العمل إلى الصياغات الأمثل، أو مساعدة القارئ بتفسير الغامض من النصوص والإحالة إلى دلالاتها؟! هل تجاوز النقد اليوم هذا الدور التعليمي الرسولي؟!! هل النقد الآن مدرك أن حاجة القراء الجدد من الأعمال الأدبية باتت إلى حد ما مختلفة، وأن ما كان مسليًّا فيما مضى، ربما يغدو اليوم عند القارئ الواعي ثرثرة باهتة ومملة تثير الازدراء؟! هل يدرك النقد اليوم أن القارئ بات يبحث عن النصوص التي تخاطب عقله، في زمن المعرفة، أكثر من مجرد مداعبة حواسه وغرائزه؟! تلك مجمل الأسئلة التي تفرض نفسها في مناقشة كهذه، وعلى الناقد أن يعي الإجابات لكل تلك التساؤلات حتى يكون على إدراك حقيقي بوظيفة النقد.
يؤكد أرنولد بنيت في كتابه (الذوق الأدبي: كيف يتكون) أن كثيرًا من الكتب الرديئة "بمداهنتها إياك، وملاطفتها لك، وجاذبيتها لناحية الضعف أو الضعة التي فيك، غالبًا ما تغريك أن تقول لها: يا لها من كتب جميلة فاخرة"(20) . وهو، في الوقت نفسه، يرشدنا إلى الطريقة المثلى في التعامل مع الكتب الرديئة "وإذا أثار كتاب فيك ازدراءً، فلك أن تنحيه بعيداً عنك"(21).
إذا كان في مقدور القارئ العادي أن ينحي كتابًا رديئًا بعيدًا عنه، وفق منظور "بنيت"، فهل يتاح للناقد الأدبي المتخصص أن يمارس ردة الفعل ذاتها؟!! هل حرفة النقد تستوجب أن يولي الناقد اهتمامه ووقته وجهده وأن يستهلك أدواته النقدية في تمريرها على أعمال رديئة؟! إن ما يمارسه "الصيرفي" في نقد الدراهم "تمييز الجيد من المزيف"، والذي اشتقت من مهمته معنى "النقد"، لا ينبغي أن يكون هو الأساس الذي يتعامل فيه النقد مع النصوص، فالمسألة تتجاوز مهمة التفسير التصنيفي البسيط إلى إدراك القيمة الجمالية للعمل. لكن ما الذي يحدد مسائل الجمال والقبح في الأعمال الأدبية؟!!
الجميل والقبيح في الفن
السؤال الذي يطرح في هذا المقام؛ كيف يتم تحديد الجميل والقبيح في الفن؟! إن "الجمال لا يعتبر في جميع الأشياء الأخرى، ماعدا العمل الفني، شيئًا ضروريًا، ولكنه يظهر في الشيء بصورة عفوية. إن المهندس الذي يصمم ماكِنة لا يفكر أن تكون هذه الماكنة جميلة، فالشيء المهم بالنسبة له هو أن الماكنة يجب أن تؤدي وظيفتها بإتقان. أما الأعمال الفنية فهي على العكس من ذلك، حيث يجب أن تملك قيمة جمالية، فإذا لم تستطع أن تنتزع هذه الأعمال الفرح والسعادة من الناس بسبب قيمتها الجمالية، فإنها ستفقد قيمتها الأخرى مثل القيمة التربوية والفكرية"(22). مع ضرورة إدراك أن "جمال العمل الفني "يعني الصدق في التعبير وهز الإنسان من الأعماق وجعله ينفعل مع مضمون العمل الفني"(23).
إن على النقد اليوم الوعي بأن النصوص الجميلة الجديرة بالفحص والدراسة هي تلك التي تخاطب قارئًا مثقفًا، لأننا لو افترضنا "أن القارئ أقل ثقافة من الكاتب واتخذنا نحوه وجهة تعليمية وتربوية وتطمينية، فإن ما نقوم به ببساطة إنما هو التباين. إن أي محاولة لتلطيف الموقف بالمسكنات ـــ مثل المناداة بأن الأدب للشعب، إنما هي خطوة للوراء وليس للأمام. الأدب ليس مدرسة. ينبغي للأدب أن يفترض جمهورًا أكثر ثقافة ـــ بل أكثر ثقافة من الكاتب نفسه"(24). فالفن العظيم "لا ينحصر في التعبير عن الأشياء والظواهر الجميلة فقط. إنه يعيد صياغة القبيح والداني صياغة جميلة وذلك لكي يعوض من خلال قيمة جمال التعبير عن قبح الشيء"(25). تلك هي مهمة الناقد في جوهرها الأصيل، أن يعين القارئ على فحص جماليات النصوص من الداخل، وأن يعلمه متى يكون الفن عظيمًا.
لكن ماذا عن مصدر الرداءة في الأعمال الفنية؟! الناقد الإنجليزي إيفور آرمسترونج ريتشاردز (1893-1979) يشير إلى أن رداءة الفن تأتي، أحيانًا، من التوصيل الرديء وأحيانًا أخرى يكون الفن رديئًا لأن التجربة التي يسعى إلى توصيلها عديمة القيمة. والنقاد، عادة، يطلقون اسم الفن الرديء على كل عمل فني من شأنه أن يثير في نفوسهم تجربة مكدرة(26). إن الجمال والقبح منبعثان من خصائص الشيء المنقود، بحسب مفهومات موضوعية وخارجية للقبح والجمل، أو إحساس المتلقي الخاص الذاتي تجاه العمل، إما النفور أو الرضا، أي بسبب الشعور الممتد تجاه العمل، بحيث يخلعه على العمل الذي حرّك فيه هذه الشعور(27). وأن يعي الكاتب بأن تجربته التي يراها مهمة وعظيمة، وذات قيمة عليا في الحياة، لا تشفع له، أهميتها، رداءة التوصيل لها، وركاكة الأداء الفني في صياغتها أدبيًا.
إن بعض الروائيين الجدد الشباب، على وجه خاص، مازالوا في مراحل تحسس الوعي الأولى، لم تنضج تجربة الحياة عندهم على نحو يهيئهم لكتابة "رواية" على اعتبار أن الأدب "لغة مكثفة من لغات الوعي وشكل مميز من أشكاله. إنه كما قيل ""استيعاب مجازي للعالم" استيعاب يتضمن رؤية الأديب إلى العالم وفهمه لحركته وموقفه من جملة التناقضات التي تتمخض عنها هذه الحركة"(28). وإذا كانت العمل عديم التجربة الواعية بالعالم من حوله، وكان الأداء الفني رديئًا، وهما أبرز القيم التي دار حولها الحديث حول مبعث الجمال في العمل الفني(29) فما قيمة الالتفات النقدي إلى هذا النوع من الأعمال الأدبية؟!! مع الاتفاق المسبق على حقيقة أن الدراسة الأدبية ليس الغرض منها "التسلية في ساعات الفراغ؛ إنما هو إيقاظ الإنسان، هو جعله حيًا، وتقوية مقدرته على الإحساس بالسرور، وعلى المشاركة الوجدانية، وعلى الإدراك الحقيقي التام. وليس الغرض أن يكون تأثيره ساعة واحدة، بل أن يكون أربع وعشرين ساعة كل يوم، هو أن يغير علاقة الإنسان بالعالم تغييرًا تامًا. وأن فهم قيمة الأدب معناه فهم قيمة العالم، ولا يعني شيئـًا آخر"(30).
النقد الأدبي أكثر من مجرد تعريف بالإنتاج الأدبي، أكثر بأن يكون مجرد راصد ومتابع لكل ما ظهر من الأعمال، الجيد منها والرديء على السواء، الناقد خلدون الشمعة يستشهد في هذا الصدد بقصيدة قديمة توصي النقاد بأن لا يتعرضون للأعمال الرديئة لا بالنقد ولا بالتعريض، لأن من ينهش عملاً أدبيًا رديئًا فإنه سيكون أشبه بالكلب الذي يعضُّ رجلاً مسمومًا "يموت الكلب ويشفى الرجل المسموم"(31). فالصخب الناشئ، في كثير من الأحيان، بوجود أزمة في النقد، لها جذورها التي ترجع إلى وجود أزمة في الإنتاج المنقود، وبأصحاب هذا الإنتاج(32). وهو سبب يحيل إليه كثير من النقاد؛ تراجع النقد وراءه تراجع الطرح الإبداعي المميز، فالنصوص الرائعة تستفز النقاد، عادة، للعكوف على دراستها وإبراز مكامن الروعة فيها.
إن وجود أزمة في الإنتاج المنقود تكمن، إلى حد كبير، في غياب معنى أن تكون كاتبًا أدبيًا، لا تشبه الآخرين، عند كثير من الممارسين للكتابة الأدبية.
معنى أن تكون كاتبًا أدبيًا
أن تكون كاتبًا أدبيًا يعني أن تكون موهوباً في خلق كائنات وحكايات استثنائية، وهو استعداد مبكر يكمن في تمرد الكاتب على المألوف، وذلك بإبحاره في حيوات بعيدة عن الواقع يعبِّر بشكل غير مباشر عن رفض نقدي للحياة والعالم الحقيقيين، وعن رغبة في رسمهما حسب خياله ورغباته"(33). فالأدب، والرواية على وجه الخصوص، ليست انعكاس تام للواقع، وإنما كما يقول "لوكاتش"، شكل من أشكال انعكاسه. وإن واحدة من الإشكاليات التي تنال مفهوم الأدب عند الكتّاب هو في نقلهم الحياة الواقعية، كما هي، على الورق.
إن الإبداع الأدبي "الذي هو فن خلق الشخصيات "النماذج" يتطلب خصب الخيال، والحدس، و"الخلق". فالأديب الذي يصور تاجرًا يعرفه، أو موظفًا، أو عاملاً فإنه يرسم صورة ناجحة لهذا القدر أو ذاك لهذه الشخصية بالذات. ولكن الصورة تبقى صورة ليس إلا. فبتجريده لها من المعاني الاجتماعية والتربوية، فإنها لا توسع مداركنا، ولا وعينا حول الإنسان وحول الحياة"(34). فالفن الحقيقي ليس محاكاة طبق الأصل عن الواقع، بل هو الصراع الجدلي مع هذا الواقع "إن الصراع مع الواقع (الحقيقة) الذي يعد سر وجود الأدب ــ والموهبة الأدبية ــ ليقود هذا الأخير لأن يقترح علينا شهادة فريدة عن حقبة معينة. فالحياة في هذه التخييلات ـــ وخاصة الأكثر نجاحًا فيها ـــ ليست أبدًا ما عاشه حقًا الذين خلقوها وكتبوها وقرؤوها واحتفلوا بها. ولكن الحياة المتخيلة، تلك التي خلقوا اصطناعًا لأنهم لم يعيشوها فعلاً، وبالتالي اكتفوا بعيشها ذاتيًا وبشكل غير مباشر، مثلما نعيش الحياة الأخرى: حياة الأحلام والمتخيلات"(35). فضلاً عن قدرة الكاتب على التأمل ورصد تلك الأشياء المألوفة لدى الناس، وتصويرها داخل العمل بكل تناقضاتها وتأثيراتها الخفيّة.
فالأديب الحقيقي هو من يدرك أبعد من الواقع المعيش الذي يدركه الناس جميعًا. على سبيل المثال "العقدة" التي كثيرًا ما يتعاطى معها الكتّاب بسطحية وسذاجة واختلاق، على نحو مدرسي تقليدي. تقول الكاتبة "فرجينيا وولف" عنها: إنها ليست ضرورية، وليس على الكاتب أن يزعج نفسه باختلاقها. فليست البراعة الفنية للكاتب بأن يصف حدثاً مثل: شجار نشب بين شخصين في الشارع، أو معركة حرب، أو مغامرة حب، مما يمكن أن يتخذ أساسًا لعقدة ينهض عليها العمل القصصي. لكن البراعة هي أن يصور الكاتب اللاشيء، الفراغ الذي تتكون منه حياتنا، ساعات العمل الرتيبة. فهو في هذه الحالة سيصف ما لا يوصف، ويرى ما لا يُرى، ذلك أن إدراك الأحجام الكبيرة سهل للغاية، يمكن أن يلاحظه كل الناس، لكن الإحاطة بالذرات المتناهية الصغر تحتاج إلى عيون خبير(36). وكذلك "الشخصيات" في القصص، وهي العنصر القصصي الذي يتسم عند كثير من الكتّاب التقليديين بثبات الملامح والوضوح، تصف فرجينيا وولف سر جاذبيتها للقارئ، بأنها تلك الشخصيات التي تبدو "كقطعة فلين على بحر ثائر"(37). فالقصص الرائعة، على حد وصف لويس منك L.Mink: "لا تعاش، بل تُروى. فليس في الحياة بدايات وأواسط ونهايات... بل انتقلت الصفات السردية من الفن إلى الحياة"(38). هنا تكمن عظمة الفن الحقيقي.
إن الكتابة الأدبية عملية شاقة ومنهكة، ليست مجرد تسلية، ولا بابًا يسيرًا للشهرة، ذلك أن "الموهبة تتغذى من حياة الكاتب تمامًا نظير الدودة الوحيدة في الجسم الذي تغزوه"(39). على الكاتب وفق منطق الاستحواذي السلطوي للكتابة أن يولي موهبته عناية فائقة، لعلّ أهم ملامح تلك العناية، القراءة الدائمة للأعمال العظيمة، واكتشاف سر هذه العظمة.
إن كون الكتابة الأدبية عملاً شاقًا فريدًا من نوعه، وليس قرارًا محضًا، هو الذي استدعى كاتبًا مميزًا مثل "كارلوس ليسكانو" للسؤال الإشكالي الذي ربما يتبادر إلى ذهن أكثر الكتّاب مجدًا في الكتابة الأدبية: "لماذا قد يقضي شخص ثلاثين أو أربعين سنة وهو يكتب في صمت!! ألكسب المال؟ أمن أجل المجد؟ قد يكون هذا مبررًا، لكن هناك طرقًا أخرى أكثر نجاعة لبلوغ ذلك. إني منبهر لكوني قضيت كل تلك المدة في أداء هذه الوظيفة المنفردة والتي لا مبرر لها... في كل محاولاتي، كنت أحاول أن أجد جوابًا لهذا السؤال: من أنا؟ لأنه وككل الناس، "ماذا أفعل" هو الذي يحدد من أنا. إنها حلقة مفرغة، وأعتقد أنني لن أجد إجابات حتى لحظة موتي(40). هذا التساؤل في معنى أن تكون كاتبًا، وليس أي شيء آخر، راود كثير من الكتّاب المحترفين للأدب. الكاتب أرسكين كالدويل حَدّث نفسه بذات السؤال، مقرًّا بمشروعيته: "كل روائي احترف الكتابة واعتبرها مورد رزقه، قد يسأل نفسه وقت ما على الأرجح كيف حدث وأصبح كاتبًا وليس ممثلاً، أو مصرفيًا، أو بائع أحذية؟!!"(41). مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشقة المسألة وإنهاكها لدى الكاتب الحقيقي "أنا متأكد من أن كتابة القصص القصيرة والروايات لم تكن أمرًا هينًا أقوم به بسهولة ويسر. فالمهمة تضنيني وتتعبني وتقلقني حين أواجه النتائج. لأن فعل الكتابة يعاند مزاج المرء وميله الفطري. فهو يعني البقاء في حالة من الضيق والتوتر والنكد طيلة النهار أو الليل، وأنا جالس أمام الآلة الكاتبة، بينما أرغب بالخروج من المنزل لأفعل شيئًا أعتقد جازمًا بأنه أكثر إمتاعًا وإثارة من الكتابة"(42). ربما استطاع الكاتب "ليسكانو" في كتابه "الكاتب والآخر" أن يعبر عن سلطة الإبداع بقوله الوجيز "كل كاتب هو ابتكار. ثمة فرد هو واحد، وذات يوم يبتكر كاتبًا ويصبح خادمًا له. ومنذ تلك اللحظة يعيش كما لو كان اثنين"(43). ذلك هو معنى أن تكون كاتبًا مشتغلاً بحرفة لا تشبه الحرف الأخرى، في مشقتها، واستحواذها، وإمتاعها الآخرين.
إن النقد الجاد الرصين هو الذي يعي بأن العمل الأدبي لا بد أن"يدفع إلى العالم شيئًا جديدًا"(44). وأن "تاريخ الإبداع والعمل الإنسانيين أهم بكثير من تاريخ الإنسان ذاته. فالإنسان يعيش حتى المئة، ومن ثمّ يموت، بينما تعيش أعماله قرونًا"(45). فمهمة النقد الحقيقي ليست يسيرة. النقد هو الوسيط المسؤول عن إجابة سؤال القارئ الافتراضي: لماذا يكون عملاً أدبيًا رائعًا وعظيمًا دون سواه.
لائحة المصادر والمراجع:
(1) الحمداني، حميد. القراءة وتوليد الدلالة: تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي. بيروت ـــ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2003، ص9.
(2) المرجع السابق، ص10.
(3) أبو هيف، عبد الله. النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2000، ص110.
(4) على سبيل المثال رواية "بنات الرياض" لرجاء الصانع، و"سعوديات" لسارة العليوي، و"شباب الرياض" لطارق العتيبي، و"المطاوعة" لمبارك الدعيلج، و"حب في السعودية" لإبراهيم بادي، و"بنات من الرياض" لفايزة إبراهيم، و"العباءة" لمها الجهني.
(5) اليوسف، خالد. "الرواية في المملكة العربية السعودية حتى أكتوبر 2006: دراسة ببليوجرافية"، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج13، ع1 (يناير/ يوليو 2007)، ص 339.
(6) إن مفهوم الكتابة النسوية Feminist Writing يختلف بالتأكيد عن كتابة النساء Women’s Writing إذ يعني الأول الكتابة من وجهة نظر نسوية سواء كانت الكتابة مـن إبداع امرأة، أو من إبداع الرجل، وإن كان الغالب هو أن تكون من إبداع المرأة لأن وجهة النظر تلك تمثلها، وتعكس قضيتها. أما الثاني فيعني ما تكتبه النساء تعبيرًا عن وجهة نظرهنّ بشتى الموضوعات، سواء كانت هذه الكتابة عن النساء، أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخر، المهم أن يكون الكاتب امرأة. الظاهر، رضا: غرفة فرجينا وولف: دراسة في كتابة النساء (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 2001) ص10.
(7) على سبيل المثال، ما قام به الكاتب محمد عالم الأفغاني حين اضطر إلى نقد قصتيه في مقال له نُشر آنذاك في مجلة المنهل السعودية سنة (1375) أسماه "الأفغاني ينتقد قصتيه". انظر، الهاجري، سحمي. القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها حتى عام (1384/1964). الرياض: النادي الأدبي، 1987 ص 239 – 240.
(8) للاطلاع إلى مقدمات الكتَّاب العرب للأعمال القصصية السعودية، بوصفها أقدم الإشارات النقدية، يمكن الرجوع إلى: الزهراني، أميرة علي. القصة القصيرة السعودية في كتابات الدارسين العرب. الرياض: دار ابن سينا، 2002، ص 21-25.
(9) الدغمومي، محمد. نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر. الرباط: منشورات كلية الآداب ــــ رسائل وأطروحات، 1999، ص 263 - 264.
(10) المرجع السابق، ص 228-231.
(11) المرجع السابق، ص 228-231.
(12) زكي، أحمد كمال. النقد الأدبي الحديث: أصوله واتجاهاته. بيروت: دار النهضة العربية، 1981، ص8-9.
(13) ديتشس. مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ص 413.
(14) العوفي، نجيب. درجة الوعي في الكتابة. الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 1980، ص 11.
(15) الشمعة. النقد والحرية: دمشق: إتحاد الكتاب العرب، ص 245-246.
(16) انظر مبحث "المبالغة في الإطراء "في النقد الذي قدّمه الكتاب العرب لأدبنا في كتابي"القصة القصيرة السعودية في كتابات الدارسين العرب" مرجع سابق. ص 183 - 186.
(17) انظر على سبيل المثال حديث سعد الحميدين "إن غياب النقد الأدبي الجاد والمحايد أفسح دون شك المجال لرواج الأعمال الرديئة واختفاء الأعمال الجيدة بفعل المجاملات وعمليات الترويج التسويقية المفتعلة" جريدة الرياض (الخميس 1/ فبراير/ 2007) ع 14101، مقال سعد الحميدين في زاويته "لمحات" بعنوان "زمن الرواية السعودية" ج1.
(18) انظر على سبيل المثال إلى إجابة الناقد محمد العباس عن الذي يجهده في التعامل مع النصوص الحالية، أجاب: "رداءة النصوص، وكمها المتعاظم، فالكثير مما ينتج لا علاقة له بالإبداع حتى من الناحية الشكلية، لأن أغلب الذوات التي تقارب الفعل الإبداعي غير ناضجة معرفيًا وفنيًا، ولا تملك الاستعداد للتعلم أو حتى التأني لإنتاج نص مقنع، يزيدها غرورًا سهولة النشر، ووجود طبالين يغدقون المديح المجاني. وعليه يبدو الفعل النقدي الجاد، الذي يحاول البناء وكأنه حالة من حالات العرقلة والتشفي في المبدع. وباختصار المبدع عندنا على درجة من الهشاشة الإبداعية والنفسية ..."مجلة الشرق، (25/ أغسطس/ 2006) ع 1327 91، حوار مع محمد العباس، أجرى الحوار: سكينة المشيخص.
(19) كالدويل، أرسكين. اسمها تجربة. ترجمة معين الإمام. دمشق: دار المدى، 2006، ص102.
(20) بنيت، أرنولد: الذوق الأدبي كيف يتكون، ت: علي محمد الجندي. الفجالة: مكتبة نهضة مصر، 1957، ص65.
(21) المرجع السابق، ص65.
(22) الرشيد، عدنان. مفهوم الجمال في الفن والأدب، كتاب الرياض، العدد 101، أبريل 2002 يصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ص131.
(23) المرجع السابق، ص148.
(24) كالفينو، إيتالو. آلة الأدب. حواران وتسع أوراق. ترجمة حسام بدّار. عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع، 2005، ص85.
(24) الرشيد. مفهوم الجمال في الفن والأدب. ص133.
(25) علي، نجاة. "حول الرداءة والقبح" صحيفة شرفات الشام الصادرة عن وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية" 1/10/2007.
(27) إسماعيل، عز الدين. الأسس الجمالية في النقد العربي: عرض وتفسير ومقارنة. ط3، القاهرة: دار الفكر العربي، 1974، ص 66- 68.
(28) العوفي. درجة الوعي في الكتابة. ص 23.
(29) إسماعيل. الأسس الجمالية في النقد العربي. ص 66- 68.
(30) بنيت. الذوق الأدبي كيف يتكون. ص 5.
(31) الشمعة. النقد والحرية. ص 246.
(32) المرجع السابق، ص 246.
(33) ريلكه، راينر ماريا. ويوسا، ماريو فاراغاس. رسائل إلى شاعر ناشئ ــــ إلى روائي ناشئ. ترجمة وتقديم. أحمد المديني. عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع. ط2، 2005، ص60.
(34) غوركي، مكسيم. كيف تعلمت الكتابة. ترجمة مالك صقور. دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع، 1990، ص13.
(44) ريلكه وويوسا. رسائل إلى شاعر ناشئ ــــ إلى روائي ناشئ. 2005، ص61.
(45) شاهين، سمير الحاج. لحظة الأبدية: دراسة الزمان في أدب القرن العشرين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980، ص166-167.
(46) إبراهيم، عبدالحميد. القصة القصيرة في الستينيات. القاهرة: دار المعارف، 1988، ص44.
(47) وورد، ديفيد: الوجود والزمان والسرد. (فلسفة بول ريكور). ترجمة وتقديم سعيد الغانمي. بيروت ـــ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1999 .ص214.
(48) ريلكه ويوسا. رسائل إلى شاعر ناشئ ــــ إلى روائي ناشئ. ص63.
(49) أركيلة، رشيد. مقالة "كارلوس ليسكانو: كنت مدفوعًا للكتابة من خلال قراءة الكتب الرديئة" بتاريخ 16 سبتمبر 2013 ـــ موقع "أبوليوس الرواية الجزائرية" موقع إلكتروني:
http://leromandz.com/?p=3620.
(50) كالدويل. اسمها تجربة. ص7.
(51) المرجع السابق. ص7.
(52) ليسكانو، كارلوس. الكاتب والآخر. ترجمة نهى أبو عرقوب. أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة – "مشروع كلمة". 2012، ص50.
(53) وورد. الوجود والزمان والسرد (فلسفة بول ريكور). ص228 .
(54) غوركي. كيف تعلمت الكتابة. ص12.
تغريد




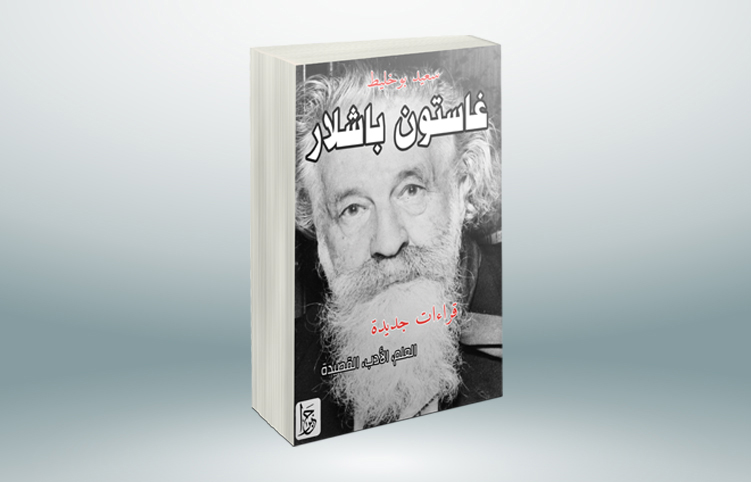

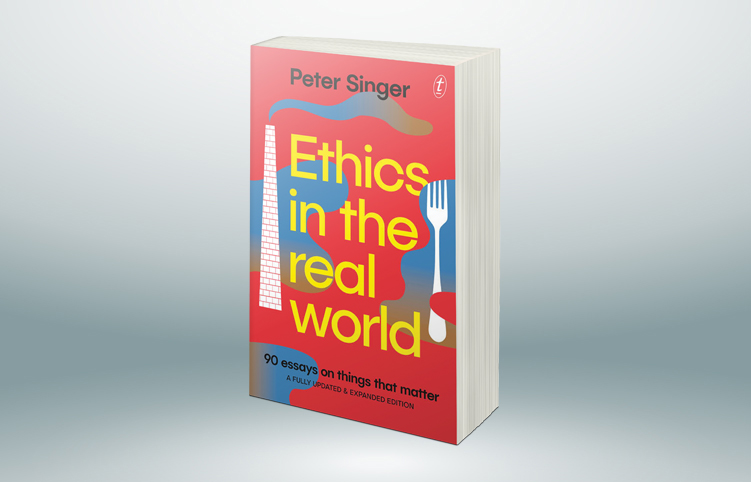
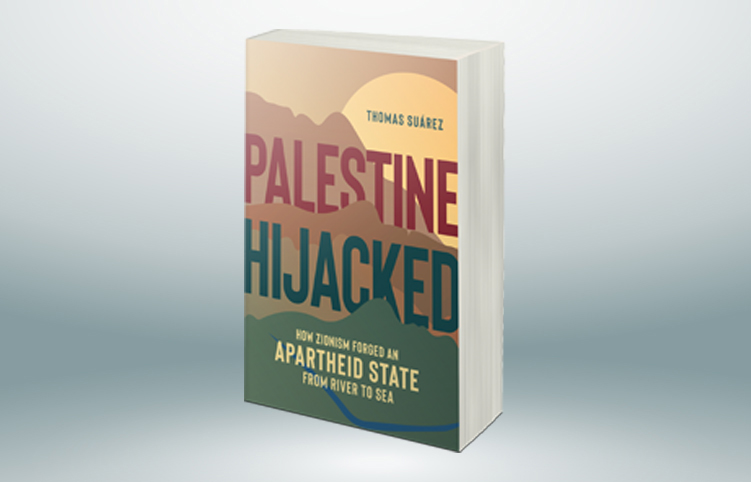


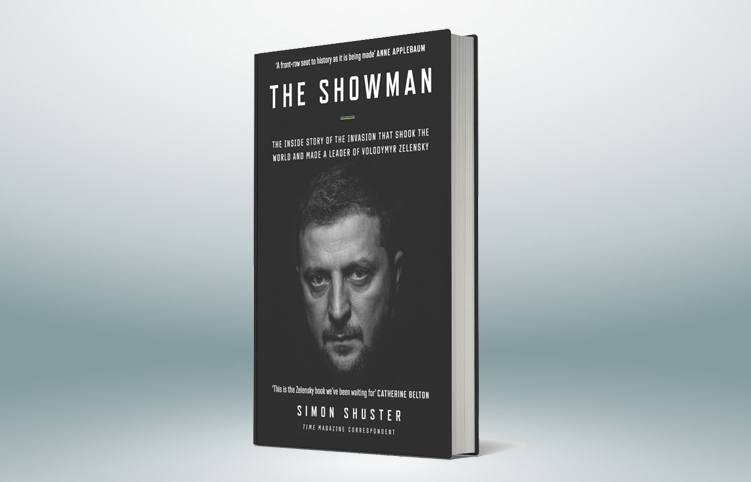






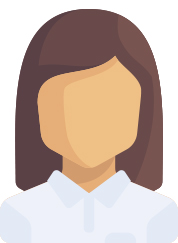
اكتب تعليقك