من جماليات الوجود الإسلامي إلى مأزق أخلاقيات الفنون الغربيةالباب: مقالات الكتاب
 | د. سامي محمود إبراهيم رئيس قسم الفلسفة- كلية الآداب جامعة الموصل – العراق |

ظلت البشرية قرون عديدة لا تفهم معنى الحياة، حتى جاء الإسلام الذي وازن بين الأرض والسماء في نظام كوني عجيب يعتمد قانون السببية، الذي يرفض الصدفة والاتفاق كما يرفض الضرورة. وبالتالي يقدم نظرة جديدة للعالم، نظرة تجعل من هذا الكون كلاً متماسكًا منسجمًا يسير إلى غايته المقصودة. هذا النظام هو الأثر الناتج عن ذلك التناسق والتناسب والتعادل والتوازن والترابط بين الأشياء. قال تعالى: (وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ) (الرحمن، 7). وقوله تعالى: (وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ ) (الرعد، 8). هذه الحقائق التي يقدمها القرآن ليست عصية على الإنسان، بل يدركها بفطرته السليمة في كل ناحية من نواحي الوجود كله وغاية الوجود الإنساني. إنه عالم الغيب والشهادة، لا عالم الشهادة فقط. إنه الدنيا والآخرة، لا هذه الدنيا وحدها، الموت ليس نهاية الرحلة إنما هو مرحلة في الطريق. وما يناله انسان من شيء في هذه الأرض إنما هو قسط من ذلك النصيب. وان الرحلة التي يقطعها على ظهر هذا الكوكب انما هي رحلة في كون كبير وفي سعة دائمة.
وهذه الروح المنبثة في العالم أجمع والجاعلة منه كيانًا منظمًا ليست بعيدة عن عقول فلاسفة الاسلام ونتائج فكرهم في مختلف مناحي الفن والجمال، حيث إن كل مادة تصبح حاملة للروح ، فلقد أدرك العقل الفلسفي هذه الحياة السارية في الكون كله، وحقيقة اتجاه روحه إلى خالقه، بالإلهام الذي فيه، ولكنها كانت تغيم عليه وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله المقيد بتجارب الحواس، ولقد استطاع أخيرًا ان يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون، ولكنه لايزال بعيدًا عن الوصول إلى حقيقة روحه الحية الواقفة على أمر الله تعالى.
فالكون متجه بحركة روحه إلى خالقه: (وَٱلنَّجۡمُ وَٱلشَّجَرُ يَسۡجُدَانِ ) (الرحمن،6). وقوله تعالى: (تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ) (الإسراء، 44).
فهذا الكون قد يبدو لغير المسلم جامدًا لا يحس ولكنه في تصور الإنسان المسلم يتمتع بالحياة والإحساس والإرادة. قال سبحانه: (إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولٗا ) (الأحزاب، 72). وهكذا يبدو الكون مشاركًا للإنسان في أسمى صور مشروعه الوجودي والمتمثلة بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور الإنساني الرفيع المتساوق مع الفطرة السليمة والمنبعث من الإيمان بالله وتوحيده، يعتبر شرطًا مهمًا في إدراك المفهوم الإسلامي للجمال. ذلك إن فكرة الجمال في الإسلام واضحة تنبع من الإيمان والتوحيد فإذا ذهب الإيمان غاب الجمال.
فلا بد أن يتوفر الجمال في ذات الإنسان وجوهره وفطرته إذ أن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه على الفطرة لتحمل معها كل عناصر الجمال فإذا فسدت الفطرة وانحرفت واختل الإيمان واضطرب بما كسبت يدا الإنسان ارتد الإنسان وفقد بذلك كل عناصر الجمال في نفسه ثم في وعيه وإدراكه. ومصداق هذا الاختلال والاضطراب في إدراك الجمال وتذوقه وجدناه في الفلسفات الغربية، إذ نشهد لديهم تلك الحيرة والارتباك فيما طرحوه من نظريات متناقضة حول الجمال وحقيقته.
إذ انحصر موضوع علم الجمال في الفلسفات الغربية على جمال الفن الذي يقصي الواقع، لا يوجد الجمال الحق إلا في مالا فائدة منه، كل ما هو مفيد واصيل ونقي.
إن هذا الاضطراب الذي ساد المفهوم الجمالي في الفلسفة الغربية راجع إلى اختلاف المنطلق العقيدي الذي يبدأ منه المفكرون وإن تزعزع القيم الدينية في الغرب والموقف السيء الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصورات الكنيسية وتاريخها قد ساعد على محاولة اقصائها عن الحياة والفكر والفن بصفة عامة، وهي ظاهرة خصام بين الكنيسة والفن كما حدث بينها وبين السياسة والعلم وقد ساهم هذا الموقف في انحرافات خطيرة للفلسفات والآداب الأوربية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقلت عدواه الى بلدان العالم الاسلامي والشرق بصفة عامة على الرغم من عدم وجود مبررات حقيقية لهذا الخصام في اطار المفهوم الإسلامي، لأن الإسلام يقدم مفهومًا واضحًا للجمال من خلال رؤية كونية شاملة يمليها العقل المستقيم والفكر السليم.
من هنا يمكن القول بأن جمالية الدين تتجلى عندما يحول الإنسان تدينه حبًّا نحو الحياة بدل الموت. والعلم أشبه بالدين في هذه المسألة فجمالية العقل العلمي تتجلى في التنازل عن جبروته والتأسيس لعالم يتسع للجميع. عالم يتعايش فيه الإنساني والإلهي معًا.
إن الجمال في الإسلام ينبع من الإيمان، إذ يشكل الوجدان الإنساني أروع ألوان الذوق الجمالي، خاصة في أشكال العبادات والعلاقات البشرية، انطلاقًا من جمالية الصلوات ولوحاتها الحية الراقية في أنسنة العمران البشري. وهذا كله يدل على أن نظرة الإسلام إلى الجمال تدعونا إلى التفكر في حقيقة وجودنا الكونية المعرفية والوجودية.
بهذا نجد أن الطابع المميز للجمالية الإسلامية هو ما يميز ثقافة المسلمين، ومن لم يتمثل هذه الروح، فأنه لا يستطيع أن يكون معرفة عن الإسلام وثقافته الجمالية. خاص أن الجمال لا يمكن إدراكه إلا بعرض مادته على القلب والعقل معًا.
لقد قدم الفلاسفة المسلمين من خلال مفهوم الجمال فلسفة واقعية تقبض على الوجود المحسوس وتنفذ إلى أغواره بأقصى ما تستطيع من التحليل والعمق والأصالة، في نظام محكم من التصورات. وهي أخيرًا طلب دائم للمعقول الذي هو شغلها الشاغل، لتقيم صرحًا شامخًا لا يفارق الأرض، قواعده أوليات العقل وبديهياته، ولبناته الوقائع المحسوسة.
وهذا يعني أن الجمال هو التكامل والانسجام بين الروحي والمادي، وفي هذا الصدد نجد أن مفهوم الجمال بلغ من العمق والاتساع إلى الحد الذي جعله من أبرز صفات العالمين الطبيعي والإلهي، ذلك أن أغلب المسائل التي تناولها العلم الطبيعي والعلم الإلهي كانت خاضعة لمفهوم الجمال فما من مسألة إلا ويدخل الجمال في أحد جوانبها.
إلى هذا الحد نحن هنا أننا أمام حياة متكاملة، امام رؤية جمالية تجاوزت الاستيعاب والشرح للفكر اليوناني. بحيث أعطتها وعيًا متطورًا للجمال والفن، ومكنتها من إحداث قطيعة فعلية مع عدد من المفاهيم التي ظلت بمثابة معوقات أمام تطور النظر الجمالي.
كما نجد أن الفلاسفة المسلمين يعلنون صراحة أن النص القرآني والعقيدة الإسلامية هما أساس فهم الجمال الكوني والإلهي، لذلك ليس ثمة جمال نافع ومفيد أو جمال مغلوط إنما هناك جمال لمعانيه ومالاته. ومن ذلك جمال المساجد حيث اتصفت بطابع جمالي مميز، كما يقول حسين مؤنس: فسواء أكنت في قرية صغيرة خافية في بطن الريف، أو ساكنة خلف كثبان الرمال في الصحراء، أو راقدة في سفح جبل، أو كانت في عاصمة كبيرة، فإن المساجد بمآذنها وقبابها تضيف عنصرًا مهمًا من الجمال.
وهكذا نجد أن الجمال في المعرفة الإسلامية كان أمام مقدس يحافظ على لفظه ومعانيه، ومن هنا ندرك أهمية تأكيد الفلاسفة المسلمين على مراعاة اللغة العربية وأصولها. أما في المعرفة الغربية فكان الجمال إزاء شكل لا يمتلك قداسة اللفظ ولا المعنى. فمثلاً وجدنا الحكم الجمالي عند كانت تذوق فقط.
وهنا لا معنى لدعوى كانت بأن الحكم الجمالي يرتد إلى أصول سابقة، خاصة أنه يحصر الجمال في الشكل دون المضمون.
وعلى هذا لا يمكن أن تكون معايير القيمة الجمالية ذات نسق معين. لذلك نجد أن فلسفة الجمال الغربية المعاصرة هي فلسفة التمزق بالمعاني والتيه بالمفاهيم.
هذا من جانب، من جانب آخر نجد أن برجسون يرى أن للكون وجود واحد ينحل ويتركب في صور أخرى عديدة. وغاية فلسفته هذه هي إلغاء الثنائية بين خالق ومخلوق، بل ونفي خالق لهذا الكون. ولا تجد في تعريفه لما يدركه الحدس برهانًا، ولا في تعريفه مفهومًا واضحًا، بل تجد المجاز تلو المجاز والتأويل ثم التأويل المضاعف إلى أن يموت المعنى.
ومن المعلوم ان الفلسفة لا تقوم على المجازات المضاعفة ولا التأويلات المنفتحة الى غير نهاية، بل لابد من لغة عامة مفهومة بمعانيها.
لذلك علق هربرت ريد على برجسون بأنه نبه الإنسان إلى الرؤية الفنية التي تخاطب حس الإنسان بلغة الشكل ما دامت حياتنا الحسية لا تتصل بالعقل.
فالمواد التي يقدمها العقل قد دخلت مقدمًا في عملية صهر وامتزاج، ثم تصلبت بعد ذلك، ثم أخذت شكل معان يأتي بها الروح دون استئذان.
وهكذا فبالرغم من أن أعمال فلاسفة الجمال، مثل كانت، وكروتشة وهيجل، وبومجارتن قد فتحت آفاقًا نحو الامتداد بالجمال إلى عوالم أكثر اتساعًا، إلا أن الانشغال بتحليل اللغة وإهمال القيمة الجمالية قد أضفى على الجمال سمة اللعب بالأفكار والتلاعب بالعقول. ومن المعلوم أن الحضارة الغربية اليوم تشهد انهيارًا للمعنى، وتراجعًا لكل ما هو جميل وقيمي إنساني أصيل.
وفي الفكر الفلسفي الإسلامي، نجد أن الجمال يلتزم بضوابط حتى لا يقع في إسقاطات ذاتية أو إيديولوجية مثل تلك التي وقعت فيها بعض الاتجاهات الغربية الما بعد حداثوية.
ومن هنا يشكل مفهوم الجمال عند الفلاسفة المسلمين مخرجًا علميًا ودينيًا مناسبًا في عصرنا للتخلص من الاتجاهات الرجعية التي تحاول بعض الاهواء اعتناقها، محرضة عن مستجدات العصر وتطوراته العلمية والحضارية من ناحية، وناسية أو متناسية ذلك الأفق المفتوح لسيل المعاني والمفاهيم الإلهية التي يمكن أن يصل إليها الفكر الانساني. فالإنسان جميل، بل هو أجمل مخلوق في الأرض، وفي هذا يحدثنا القران الكريم أن الله تعالى قد خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسنها، بل وقارن بينه وبين سائر الحيوانات. قال تعالى: (ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ قَرَارٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَصَوَّرَكُمۡ فَأَحۡسَنَ صُوَرَكُمۡ ) (غافر: 64). إن الفكر الإسلامي انطلق متحليًا بالجمال إلى جميع جوانب الحياة. ومن آيات الجمال الرباني في هذا الكون نرى لوحات رائعة يصدقها قوله تعالى: (أَمَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآۗ) (النمل: 60). قرأنا في الصحف عن لوحة جميلة اسمها أزهار السوسن رسمها (فان جوخ) وهو جالس في الحديقة.. فكيف باللوحة الطبيعية التي أبدعتها يد الخالق جل وعلا؟ نعم كل ما تقدم لا يعبر إلا قليلاً عن معاني ودلالات ومفاهيم الجمال في الفكر الإسلامي.
أما المعنى في الجمالية الغربية المعاصرة فهو نقطة الارتكاز الرئيسية لأجله يستنفر الجمال كل طاقاته ليبني معنى آخر، لذلك تتعدد المفاهيم والمعاني التي يكتشفها العقل بتعدد التأويلات، خاصة وأن اللامعقول في فضاء المعرفة الغربية المعاصرة أخذ يقتطع مساحات كبيرة من ساحة المعقول. ولا مفر للجمال من مواجهة الموت والعدم، لأن الحقيقة غائبة بل ومغيبة، والمعنى الجديد الذي تولده العملية الفنية من الجمال لا يحمل صفات وخصائص الجميل نفسه. ذلك أن الهرمنيوطيقا لا تبحث عن تأسيس صروح جمالية فلسفية، كما كان الحال مع الفلسفة الحديثة، بقدر ما هي فلسفة مختلفة تمارس التأويل على كل الثوابت واليقينيات، إذ لا توجد حقائق وإنما فقط تأويلات. وهذا ما أقره نتشه.
لذلك أيضًا أصبحت الأخلاق قضايا ذهنية تجريدية أكثر مما هي واقع عملي حياتي. والأمر عند الفلاسفة المسلمين مختلف تمامًا فالمعاني تضمن استمرار الجمال وتحميه من الزوال. وبذلك يتم الربط بين الإلهي والإنساني.
ولذلك كانت المفاهيم الجمالية بحد ذاتها تثير من خلال توصيفها اختلافًا بينا بين مفهومها الإسلامي الذي يمثل الجمال فيه ركيزة أساسية وسبيلاً إلى الاجتهاد، وبين مفهومها الغربي القائم على تأويل الجمال من خلال إقرار المنفعة واللذة، وأنه قابل لأن يحمل معاني لا يحملها أصلاً. إن التباين راجع إلى عدم امتلاك الغرب لميزان القياس الجمالي وشروط الروح وحياة ما بعد الموت، والذي يفقد الشعور بالجمال. فإن الذي يلبس نظارة سوداء لا يمكن أن تظهر أمامه الدنيا إلا معتمة قاتمة ويائسة بل وبائسة.
هكذا أعلن الفكر الإسلامي التزامه بشروط الجمال، لا كما يظن الذين أرادوا التستر بالفلسفة لإيهام العالم بأصالة الفهم الغربي للفن والجمال بهدف إحلال الدين الطبيعي محل الدين الإلهي، وصولاً إلى إحلال النموذج الغربي في التقدم والنهوض محل النموذج الإسلامي في النهضة والمدنية. وهي مقاصد تقطع الطريق عليها منهجية الفلاسفة المسلمين وبحثهم عن مفهوم الجمال وحقيقته.
إلى هذا الحد ما تزال شروط إمكان الفهم الغربي للجمال بعيدة عن المواصفات الموضوعية لكونها خاضعة للإكراهات الإيديولوجية. فالجمال هنا محكوم بالعشوائية لأنه منقاد إلى العبث والعدمية.
وهنا نحن بإزاء أزمة انسانية وقلب للقيم ونسف للثوابت، فالدراسات الجمالية ما تزال تبعد الوقائع الغيبية والحقائق الدينية لصالح الفهم النيوي ومقاربات العقل المجرد.
أن فهم الجمال لا يخضع إلى المعطيات التجريبية والنظرية فقط. وهذا ما أكد عليه الفكر الإسلامي كمرتكز لفعل الإحساس بالجمال والنفاذ إلى جوهر الدلالة في الذوق الجمالي والمعنى الروحي.
وعلى ذلك فإن الاختلاف بين الفلسفتين الإسلامية والغربية في مفهوم الجمال واضح من حيث سياق قوانين الطبيعة سواء تعلق الأمر بالخلق وعلاقته مع الخالق، أم كان ذلك بين الخالق ونواميس الطبيعة.
هذا بالإضافة إلى أن حتمية الاختلاف بين الجمال في الفكر الفلسفي الإسلامي والجمال في الفلسفة الغربية تؤدي بالضرورة إلى حتمية طرائق الوازع الثقافي، فبينما يستخدم الأول طرائق القياس الافتراضي، يستخدم الثاني معالم الأسلوب الذاتي الذي من شانه أن يسوغ تعزيز التخمين والانتقال به إلى معنى مغاير تمامًا لمعنى ومفهوم الجمال. خاصة أن المجتمعات الغربية اليوم تعاني من التفكك الأخلاقي والقيمي، وانعكس ذلك في فلسفة الجمال بتعدد لا نهائي في الآراء، وهو ما صير مفهوم الجمال غامضًا، لا يمكن تحديده في تلك الثقافة، على حين أن تمجيد الله في الفلسفة الإسلامية، أعلى من شان الإنسان، إذ ربطه بالمطلق، وأحاله إلى مرجعية واحدة، وجعل كل المخلوقات مسخرة له لتحقيق معنى خلافته في الأرض.
كما إن إشباع الحاجات الجمالية لدى الإنسان لو تأملتها تجدها لا تخرج عن معنى حاجة الإنسان الفطرية إلى التعبد والسلوك الروحي. ولذلك فإن الإنسان الغربي بدل أن يسلك بإنتاجه الجمالي مسلك التعبد لله الواحد الأحد، مصدر الجمال الحق، ثم ينحرف بها إلى إشباع شهواته بعدها يمارس نوعًا من الوثنية. ولذلك كانت فنونه الجميلة تميل إلى التجسيم ومحكومة بمثل قوله تعالى:(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ) (الأعراف:148). من هنا إذن أقر الإسلام الجمال بمفهوم العبادة، حتى يصح الاتجاه في مسيرة الإبداع، ويستضيء الفنان المسلم بثوابته مصدر الجمال الحق، وتلك هي جمالية التوحيد.
وكأنما الفرق في الجمالية بين مفهوميها الغربي والإسلامي كالفرق بين الحقيقة والخيال. كما لم تكن الصورة التي يبدعها المسلم ثابتة في المتحف والمعرض والساحة، ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه الوجودي بين ركوع وسجود ومناجاة وحوار تعبدي.
يقول (سوريو): "إن الروحية الإسلامية لها ضمانات مميزة في الفن التجريدي"، الذي يبتعد عن التشخيص. وهو خلاف التجريد الغربي، إذ أن مصطلح التجريد في الفن الإسلامي له مدلول يختلف عن مدلوله في الحضارة الغربية. لهذه الأسباب نجد أن الوضع الفني والجمالي في الغرب قد وصل إلى آفاق ضيقة. فالزائر الذي يتجول في أرجاء متحف للفن، لو انتقل من قاعة تضم لوحات انطباعية إلى قاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفن التجريدي أو التجسيمي، لاجتاحه شعور بالانتقال من عالم إلى عالم آخر، وإحساس بالغربة عميق. بينما السلوك الإسلامي انطلق متحليًا بجماليته إلى جميع مناحي الحياة. فكانت له في كل ذلك تجليات خاصة تتميز بخصوص المفهوم الإسلامي للجمال. وأهمها أنه لا شيء في هذه الدنيا الفانية يزعج المؤمن فهو دائمًا راضٍ عما قسمه الله تعالى له من نعم وجمال، لأنه يعلق آماله على الفوز بالحياة الأبدية الباقية المؤدية إلى سمو الروح والمشاعر. ولا زالت طرائق تحسين الأخلاق ذات مناهج متنوعة منها توظيف الفنون الجميلة لترقيق الطباع وغرس التربية الجمالية والذوقية في النفوس والخالية من الرذالة والابتذال.
يقول الرصافي ان الفنون الجميلة تجعل مشاعرنا رقيقة تغني جمال الحياة:
تلك الفنون المشتهاة هي التي
غصن الحـــيــاة بها يكــون وريـقـا
وهي التي تجلو النفوس فتمتلي
مـنهــا الــوجـــوه تلألُـــــؤا وبريــقــــا
وهي التي بمذاقـهــا ومــشــاقــهــــا
يمسي الغليظ من الطباع رقيقا
وهكذا توسع الفنون نطاق فكرنا، وتجدد حركتنا، وتلهم مشاعرنا بقوة الجمال وروح الإبداع.
فالإنسان يحمل خلاصه في داخله، فإنسانيته كامنة فيه بالقوة، ولا يحتاج إلى اكتسابها من غيره.
فالجمال أية من آيات الله التي أودعها في خلقه.
هذا الموقف بعيد عن الفلسفات الغربية التي تضع الإنسان في مرتبة أدنى من الحيوان، فتطلب منه العيش بغرائزه بدلاً من العقل.. إنه موقف يعطي الإنسان معنى وجوده والحياة. فالدين والفن يتناقضان إذا كانت النظرة الدينية ناقضة للقيم والاخلاق والذوق جاحدة للفطرة الإنسانية السوية.. يتناقضان إذا كان الفن يساوي اللذة والمتعة فقط.
لهذا علينا أن نتبنى التخطيط لصحوة ذوقية فنية إسلامية معاصرة تتبنى إصلاح ما تبقى من هدم الذات وهدر الكرامات والذوق السوي، وترهف حسها بمواطن الجمال في هذا الوجود صنعة وعيش.
وهذا تأمل يقود إلى اكتشاف حقيقة وجودنا واكتشاف قانون الانسجام والتناغم الحاصل في علاقة بعضها ببعض، فكل مفردات الكون موضوعة في قانون إلهى موحد محكم ومتين في غاية الجمال.
لقد مر معنا أن الفن الجمالي اليوناني قد تمثل الصراع الفوضوي الشاذ بين الآلهة والإنسان، خاصة إن الإنسان عندهم تائه، يسعى لإثبات ذاته من خلال مصارعة القدر. كما وجدنا بعض فنون الغرب الحديث تحارب المجتمع والقيم الخيرة وأهمها الوجودية التي تؤكد على العزلة والفردانية.
في ظل هذه الفوضى أنتج الفن الأوربي روائع إنسانية بارعة ولكنها روائع مشوهة بسبب تلك الانحرافات. إن ما فيها من روعة التصوير لدقائق الحياة ليأخذ الإنسان فيتمنى أن لو كانت سلمت من هذه الانحرافات اللاإنسانية التي تفسد الجمال وتشوه الحقيقة، كالصراع من أجل الفوضى الى حد التناقض. وعبثًا يطاول الوعي الجمالي أعالي الجمال المبهر والكينونة الأزلية. أليس على الجمالية، وقد استضاءت بالألوهة أن تبدأ ببلورة بشرية جميلة بتوازنها وإيقاعها الإنساني النبيل. أيضًا وجدنا التجربة البراجماتية عند جون ديوي الذي تناول مفهوم الجمال من خلال الفصل بين الذات والموضوع. فالإحساس الجمالي إنما هو تلذذ.
كما يربط جون ديوي بين الفن والمنفعة لذا يرفض الفصل بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية.
فهو يرى أن التفرقة بين الفنون الجميلة والتطبيقية نشأت عن ظروف في المجتمعات الغربية الحديثة أدت إلى ظهور فكرة المتحف باعتباره مكان الأعمال الفنية وبالتالي فان الأعمال الفنية ليست قائمة بذاتها ومستقلة عن الحياة اليومية.
وبالتالي استطاع إحالة الفن إلى مجرد نشاط أداتي لخدمة غايات أخرى حيوية أو اجتماعية فتحول عنده إلى مجرد إدراك حسي نافع.
إلى هذا الحد نلاحظ وجود اختلاف واضح معرفي ووجودي بين التصور الإسلامي للفن والجمال والتصور الغربي. اذ تنحصر مصادر المعرفة الغربية في الوجود الى واقعنا الحسي، تمتد في المقابل المصادر الجمالية الإسلامية لتشمل الوحي وما وراء المحسوس.
أيضًا نجد أن مفهوم الجمال في منظوره الغربي ألما بعد حداثوي هو مفهوم متشظي ومتهافت يبحث عن المعنى ولا يجده.
مع ذلك التشتيت نجد أن بعض اتجاهات الحداثة وما بعدها تشير إلى اتجاهات جمالية مهمة غيرت نظرة الإنسان نحو فضاءات أجمل. ذلك أن الحضارة الشاملة تتأسس على الخير وجمال القصد.
وما قتل الفن الغربي وجمال رؤيته للحياة إلا الولع بسجن المنفعة واللذة بشتى صورها الجامدة وحركتها الوهمية المصطنعة مع سيولة قصدية تعمل على إذابة الحواجز وسائر أنماط العيش الكريم. لذلك نجد أن الوضع الفني في أوروبا والغرب قد وصل إلى الطريق المسدود. مشاعر عدمية غامضة، وإحساس بالغربة عميق يتخلله سوء هضم في الأمعاء الروحية لمجرى النفس.. منتهى الانحدار نجده في حضارة اللاجدوى والتوحش.. حضارة ما بعد البعد.
فقد يخفى على الإنسان وجه الجمال في شيء من الأشياء لكون الإنسان عاجزًا عن إدراكه، ولعل مجال الجمال المعنوي أكبر دليل على ذلك، إذ لو لم يتم تنزيله لما أدركه الإنسان. فالجمال آية تدل على قدرة الخالق وإبداعه، إذ إنه لم يخلق الخلق فحسب، ولكنه خلق فأحكم.
فالطبيعة بكل ما تحتويه من أرض وسماء، وإنسان وحيوان، ونبات وجماد، تصلح ميدانًا رحبًا، ومجالاً فسيحًا للجمال. فهذا المشهد العظيم لوحة من الطبيعة، التي لا تحدها الأبعاد والأنظار، يسرح فيها العقل والبصر.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- المعنى ومنهج التحليل المعاصر فتجنشتاين أنموذجًا
- صورة الشرق بين سلطة المعرفة والاستشراق
- العقلانية الكانتية وتطبيقاتها جماليًا: دراسة في فلسفة "كانت" الجمالية
- إشكالـية العـقـل والإنسـان في فـكـر ابن بـاجـة
- من جماليات الوجود الإسلامي إلى مأزق أخلاقيات الفنون الغربية
- الفلسفة بمتعة الكينونة وقصدية الحياة




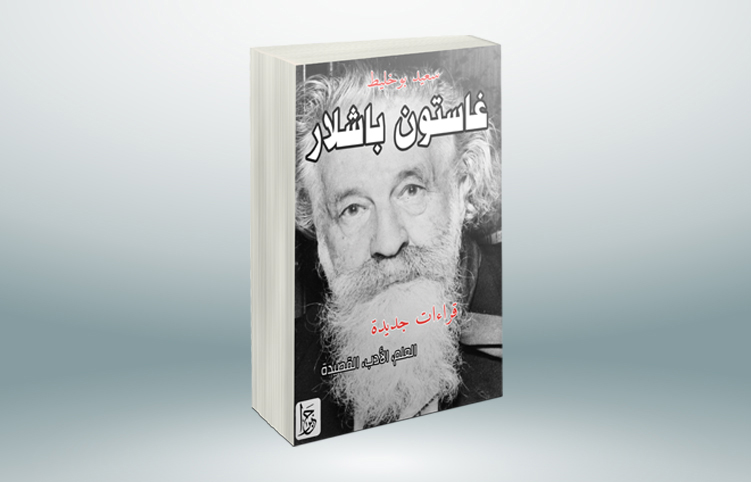

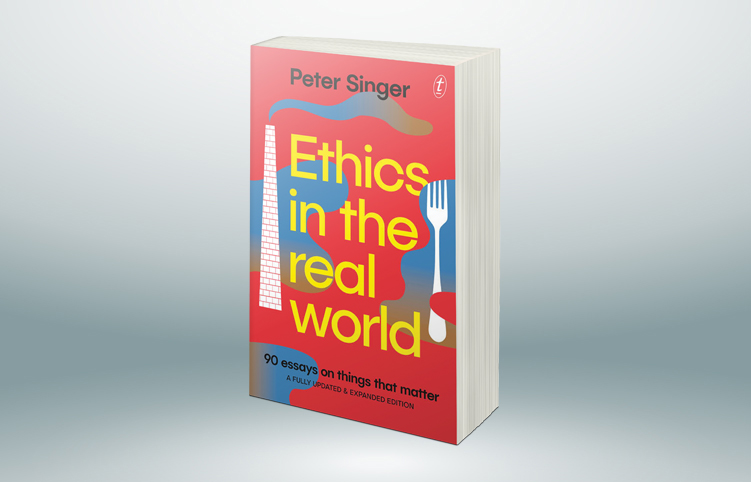
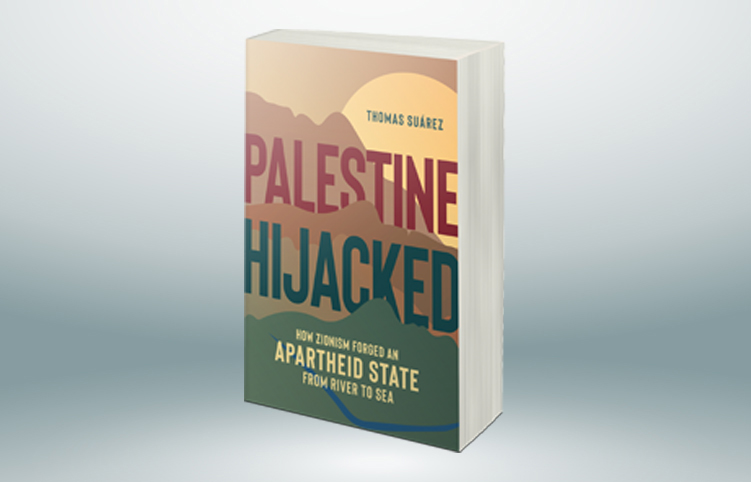


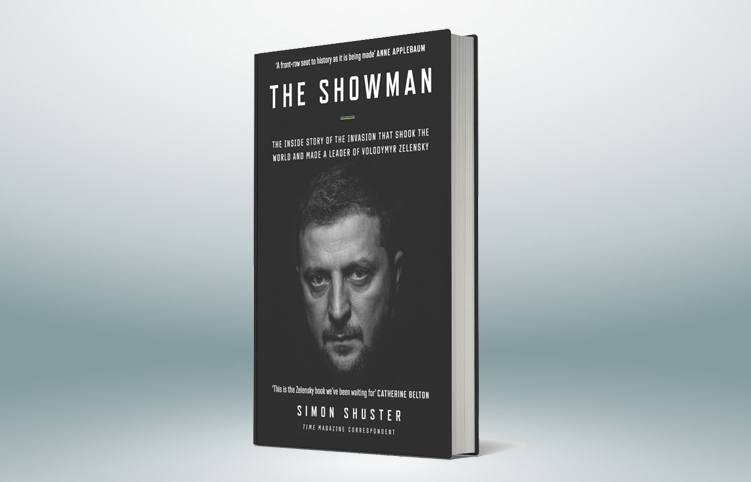






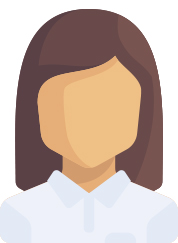
اكتب تعليقك