التحيز في الأدب 2-2الباب: مقالات الكتاب
 | أ.د. إبراهيم بن محمد الشتوي أستاذ الأدب والنقد |
ولم يكن القدماء بمعزل عن الوعي بهذا التحيز الذي تتسم به المواقف الأدبية. والمقولة المشهورة المنسوبة إلى بشار بن برد تثبت ذلك؛ فقد روي أن بشارًا كان يقول عن الثالوث الأموي (الأخطل، والفرزدق، وجرير): «إن الأخطل لم يكن كصاحبيه، ولكن تعصبت له ربيعة»؛ وذلك أن الفرزدق وجريرًا كانا من مضر؛ فكانت المنزلة التي احتلها «الأخطل» في رأيه بسبب موقف ربيعة منه الذي دعتها العصبية حتى يكون لها مكان بين سادة ذلك العصر من الشعراء. وهذا يذكرنا بالمقولة المشهورة: «كذاب ربيعة خير من صادق مضر».
لكننا لا نستطيع أن نقبل قول بشار على إطلاقه، ونبعده هو أيضًا من تهمة التحيز لمضر ضد الأخطل، خاصة أننا نجد من القدماء من يفضل الأخطل على صاحبيه، ويعده أجود الثلاثة. وكان على رأس هؤلاء أبو عمرو بن العلاء الذي روى عنه الأصمعي أنه كان يقول: «لو أدرك الأخطل يومًا من أيام الجاهلية ما فضلت عليه أحدًا». ويروي أبو حاتم أنه سأله (الأصمعي) عن الأخطل فأنشد بيتًا من قصيدته:
لعمري لقد أسريت لا ليل عاجز
بساهمة الخدين طاوية القرب
يقول أبو حاتم: «فأنشد أبياتًا زهاء العشرة، ثم قال: من قال لك إن في الدنيا أحدًا قال مثلها قبله ولا بعده فلا تصدقه».
وحين نطبق معيار الفحولة السابق الذي يقوم على ربطها بغرضي الشعر (المدح، والهجاء) نجد الأخطل قد تقدم على صاحبيه - كما يقول بشار - بالمدح؛ فقصائده المدحية في عبدالملك بن مروان لم يبلغها أحد، ثم إن الأخطل قد جدد في القصيدة العربية؛ فكان بناؤها متسلسلاً، مترابطًا، على خلاف من كان قبله.
هذا أولاً. وثانيًا: إن بشارًا محسوب على مضر؛ أليس هو القائل:
إذا ما غضبنا غضبة مضرية
هتكنا حجاب الشمس أو أمطرت دما
وبشار العقيلي من بني عقيل من عامر بن صعصعة، وهو وإن كان بالولاء فإن القدماء كانوا يعدون الولاء من النسب، ويفخرون بفعل مواليهم، كما كان الموالي يفخرون بمن ينتسبون إليهم، كما كان أبو نواس يتعصب لليمانية على العدنانية، وكان دعبل يفتخر بطاهر بن الحسين، ويعده منه، وكان خزاعيًّا بالولاء، فيقول:
إني من القوم الذي سيوفهم
قتلت أخاك وشرفتك بمقعد
يقصد طاهرًا عندما قاد الجيوش، وحاصر بغداد للمأمون.
هذه العصبية المضرية في الأدب تظهر ملامحها في مواطن أخرى؛ إذ يروى أن عبدالملك بن مروان كان في مجلس أُنسه، فذكر بعض من حضر ذا الرمة، وقال: «إنه من الشعراء الكبار، وأنه لو أدرك الجاهلية لكان له شأن بين شعرائها». يقول الراوي: «فأخذت عبدالملك الحماسة والحمية لمضر، وأمر بمن يحمله إليه، ويأتي به من البادية».
فالراوي أدرك أن سبب عناية الخليفة بذي الرمة لا تعود إلى العناية بالشعر وحده، ولا تعود أيضًا إلى ذي الرمة بوصفه شاعرًا كبيرًا، وإنما لأنه ينتمي إلى مضر الذي ينتمي إليها الخليفة. وقد لا يكون ما جال في خاطر الراوي قد جال في خاطر الخليفة، ولكن ورود مثل هذا الظن في ذهن من كان في المجلس يكشف عن الذهنية المسيطرة على تلقي الأدب في ذلك الزمن، التي تقيم اعتبارات متعددة، ليست بالضرورة فنية.
على أننا نجد موقفًا آخر كان في مجلس عبدالملك بن مروان، يمكن أن يعزز ظن المتلقي السابق، بأن حمية مضر هي التي دفعت عبدالملك لموقفه ذاك؛ فيروى أنه كان في مجلسه ذات يوم فقال لجلسائه: «أي المناديل أفضل؟». فقال أحدهم: «مناديل اليمن؛ كأنها أنوار الربيع»، وقال آخر: «مناديل مصر؛ كأنها غرقيء البيض». فقال عبدالملك: «ما صنعتما شيئًا. أفضل المناديل ما قال أخو تميم (يعني علقمة بن عبدة):
ثمت قمنا إلى جرد مسومة
أعـرافـهـن لأيدينا مناديل».
وهذا المعنى في الأصل لامرئ القيس في قصيدته المشهورة:
خليلي مرا بي على أم جندب
نقـض لبنانـــات الـفـؤاد المـعــذب
حين يقول:
نمش بأطراف الجياد أكفنا
إذا نحن قمنا عن شـواء مهضب
فعدل عن بيت امرئ القيس مع أنه السابق، واتسم بالإيجاز؛ فقد أتى بالمعنى في بيت واحد إلى أبيات علقمة التي أوردت المعنى ببيتين، وكان متأخرًا. وقد قضى النقاد القدماء الحكم بالمعنى للسابق تاريخيًّا، وللسابك من حيث البناء الفني، في حين لم يأتِ علقمة ببيته بجديد يُضاف إلى ما قاله امرؤ القيس، يجعل عبد الملك يخصه بالاستشهاد، غير أنه من مضر.
ولم يكن الوعي بالتحيز مقصورًا على الموقف النقدي، بل تجاوزه إلى الموقف العلمي أيضًا. وإذا تجاوزنا الحكاية المشهورة الزنبورية التي يروى فيها أن الكسائي قد رشا الأعراب الواقفين بباب الخليفة عند مناظرة سيبويه، وكانت سببًا في وفاة سيبويه، فإن هناك مرويات أخرى تدل على الوعي بالتحيز، لا تصل الرشودة في فسادها، ولكنها تكشف عن الطرائق التي تكونت فيها الحركة العلمية، وأن المواقف العلمية كذلك لم تكن موضوعية.
ففي فهرست ابن النديم، يذكر المؤلف حكاية بداية أبي الأسود الدؤلي النحو، إذ يروي أن ذلك كان بطلب من زياد بن أبيه، وأنه اعتذر في بادئ الأمر، ثم عاد مرة أخرى، وطلب أن العمل بما كان قد رفضه، وأراد كاتبًا يعينه على ما يقول، فأتي بكاتب من عبد القيس فلم يرضه، فأتي بآخر يقول المبرد: أحسبه منهم. أي من الدؤل، فكتب له. والذي يهمني من هذه الحكاية أمران:
1 - أن الكاتب الأول رفض من غير سبب، وحين منح كاتب آخر من الدؤل قبل. وقد عرف مرسل الكاتب الأول سبب الرفض، فأرسل له كاتبًا آخر منهم، فكأنه قد قضى على السبب المانع من استعمال الكاتب الأول. ولأن المرسل قبل موقف أبي الأسود، فإن هذا يعني أنه يتفق معه على وجاهة موقفه، وهو ما يعني مرة أخرى أنه يتواطؤ معه على القيم ذاتها التي تقوم من خلالها صلاحية الفرد للعمل المنوط به، ثم يكشف الوعي الجمعي للمجتمع الذي تمت فيه الحادثة.
2 - موقف راوي الحكاية، فهو يقف عند مقطع من القصة «موتيف» دال، أو هو يراه دالاً، ويستحق النقل، إذ يكشف حقيقة تكونات الأوساط العلمية، وإن كان يمثل في وعيه حالة مغايرة لما ينبغي أن يكون الواقع عليه، بدليل أنها تستحق الوقوف، والنقل، ومن ثم الكشف. هذا الملمح أو الفرق الدقيق بين المرفوض والمقبول، لم يكن ليخطر على بال أحد لو لم يكن مستقرًا في وعيه، وسببًا لمعاناة عدد كبير من الشداة، وطلاب العلم في ذلك الزمن.
هذا الملمح السريع الذي ينقله المبرد (وهو من الأزد بالمناسبة) يقدم التفسير لقضية طالما ألحت على الباحثين في تاريخ الفكر العربي القديم، لماذا كان أكثر العلماء القدماء في اللغة، والنحو والتفسير وغيره من الأعاجم، والفرس على وجه التحديد؟
كان التفسير المشتهر هو أن العرب، كانوا مشغولين بالفتوحات، وقيادة الجيوش، أو أنهم أعراب لا يقدرون على طلب العلم، والمعرفة إلا قليل منهم، ولكن هذه الحادثة التي يرويها صاحب الفهرست، وما صاحبها تعليق للمبرد، والحادثة الأخرى المشهورة التي دفعت الرشيد إلى نكبة البرامكة حين منعوا دخول الناس من العرب عليه، تعني أن هناك تحيزًا ليس في الجانب السياسي وحده، ولكن أيضًا في الجانب العلمي، بحيث إن العالم يختار تلاميذه، ومن يقربهم إليه، ويخصهم بعنايته، واهتمامه حتى يدركوا ما لديه، ويحملوا العلم من بعده، فيظل العلم يدور في فلكهم، وإذا أقبل ممن سواهم فإنهم لا ينالون شيئًا.
التعصب، والتحيز بين علماء البصرة والكوفة، أو علماء الحجاز والعراق مشتهر، وإليه أعاد بعض الباحثين من أمثال ناصر الدين الأسد ما روي عن ذم لخلف وحماد، إذ يقول: «وكان من أثر هذا الخلاف في المنهجين أن تعصب كل فريق لمدرسته، وأخذ يتهم، ويضعف علماء المدرسة الأخرى، خاصة البصريين الذين كانوا يرون أنهم أخذوا اللغة عن العرب الخلص، وأن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين فسدت لغتهم، وسليقتهم، ويروي عن الرياشي أنه يقول: «إنما أخذنا اللغة عن حرشة الضباب واليرابيع، وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أكلة الكواميخ، والشواريز».
وهذا التفاخر أدى لأن يجمل كل واحد نفسه، ويقبح الآخر، يقول أبو حاتم: «فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها، أو حكيت عن العرب شيئًا، فإنما أحكيه عن الثقات عنهم مثل أبي زيد والأصمعي.. إلى أن يقول: ولا ألتفت إلى رواية الكسائي، والأحمري، وغيرهم، وأعوذ بالله من شرهم».
وفي مقابل ذلك روي عن ابن الأعرابي أنه كان يزعم أن الأصمعي، وأبا عبيدة كان لا يحسنان كثيرًا ولا قليلًا، ويروى أنه كان يقول: إنه سمع من ألف أعرابي على خلاف ما كان يقوله الأصمعي.
هذا التعصب إلى المدرسة العلمية، أو إلى المدينة كان معروفًا، ومقبولاً إلى حد ما، لأنه كان في الغالب تعصبًا يقوم على المنهج العلمي، فهو ليس للأشخاص بوصفهم أشخاصًا، وإنما بناء على الرؤية العلمية التي تربى عليها النشء وأخذ عنها، وأصبح لا يرى الحقيقة كما تبدو في الطرف الآخر، فهو من طبيعة العلم أولاً، ولأنه يثري الحراك العلمي بوجود أكثر من رؤية ومنهج. أما التعصب كما ورد في الأحاديث الأولى، فهو تحيز لا يقوم على رؤية علمية، وإنما مرده الفروقات الشخصية وهو ما يؤذن بالخلل في بنية المؤسسة العلمية، وفسادها.
تغريد
اقرأ لهذا الكاتب أيضا
- التحيز في الأدب 1-2
- التحيز في الأدب 2-2
- الهوية والقومية
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة)1 - 2
- طبائع المؤسسة (حياة في الإدارة) 2 - 2
- من «وحي الحرمان»
- الموقف من الآخر في السرد العربي
- جماليات القبيح
- بلاغة المهمشين
- أدبيات البرجوازيين
- ثقافة المديح
- كتابة تاريخ الأدب
- سرديات شوقي ضيف
- نـــقــــاد الــعــجـم
- شعرية شعر الحكمة
- قول في الكلام
- اللغة والمجتمع
- الأدب والصنعة
- الأدب المترجم
- أغلاط المتنبي
- جناية الأدب المصري على الأدب العربي الحديث
- الشوفينية المصرية
- الجنسانية المصرية (1)




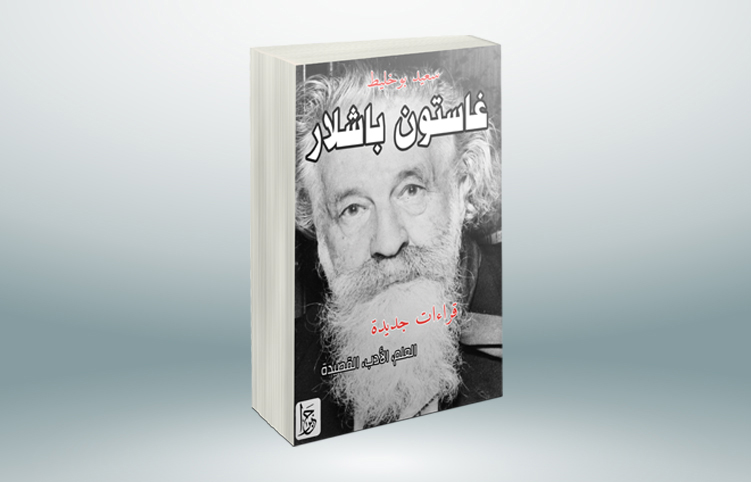

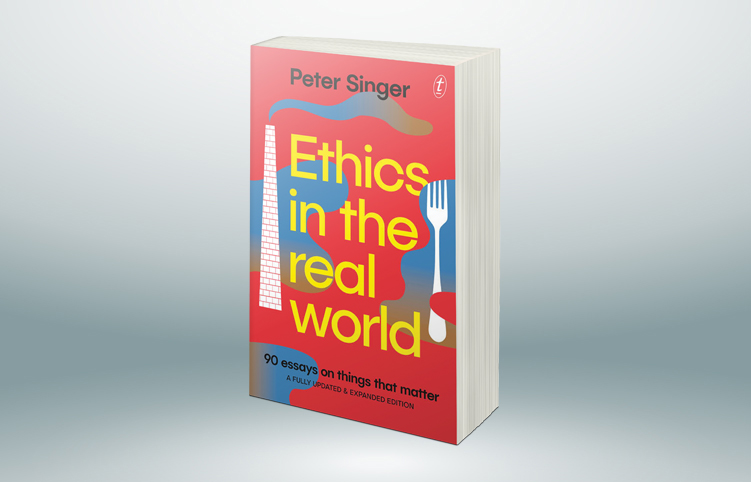
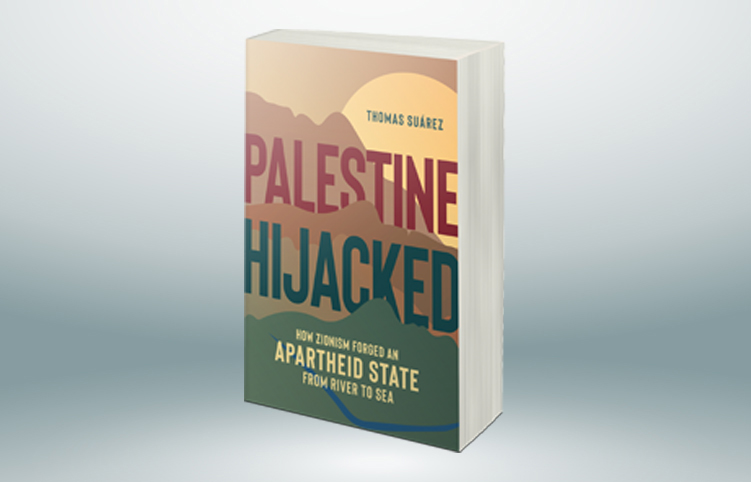


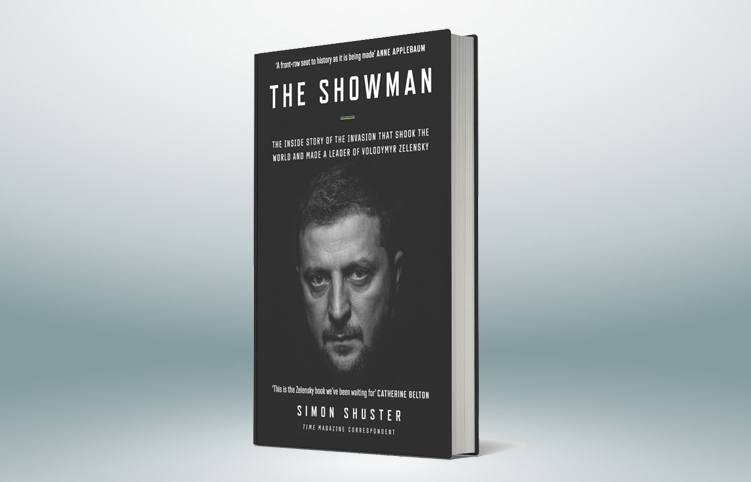






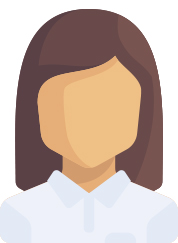
اكتب تعليقك