التمرد النسوي والجمالي لدى شاعرات القصيدة العربية الجديدةالباب: مقالات الكتاب
 | شريف الشافعي شاعر وكاتب من مصر |

تنعكس تجليات التمرد المجتمعي والجمالي، والثورة النسوية، في العالم العربي، في أعمال شاعرات متميزات، من أقطار عدة، إذ استطعن بكتابتهن الشعرية خلال الفترة الوجيزة الماضية إحداث حراك على الصعيد الفني، يتوازى مع طرح مغاير للثابت المجتمعي في الكثير من الأحوال، الأمر الذي يعد محاولة حقيقية للإطلال على غد أكثر إشراقًا وتنويرًا.
الشاعرة السورية لينا شدود، في ديوانها "من قلب العالم.. من عالم بلا قلب" (سلسلة الإبداع العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة)، تراهن على عدم الالتفات إلى الوراء كقيمة أساسية للولوج إلى عالم جديد، منفتح على نبض فعّال. هي تبعث رسائلها من قلب العالم، معترفة بأن العالم بلا قلب، لكنها متمسكة حتى آخر لحظة بالشغف المستحيل، وبالشرارة الإنسانية، القادرة على خلق الصاعقة، وتجاوز مشقة البقاء. تقول لينا شدود في ديوانها:
"لن تنطفئ عظمة حيرتكَ،
وأنت تصطكُ شغفًا.
هل تنتظر انقضاض الصاعقة،
كي تتخلّص من مشقّة هذا البقاء؟
وحدها الأنهار لا تلتفت إلى الوراء،
وحدها الأنهار في جريانها المندفع،
تهدّئ من روع الجبال"
تطرح الشاعرة رغبة محمومة في التمرد، على كل المستويات، بوصفها الإنساني وليس فقط بوصفها الأنثوي. هي تدرك أن الرحلة إلى قارة نادرة تبدو رحلة بعيدة، غير مأمونة العواقب، لكن التحرك بحد ذاته قيمة تستحق التجريب، وربما التضحية. الابتعاد موت مؤكد، وللوصول سكرات، لكن هذه السكرات قد تكون بمثابة رعشة الحياة.
لا أمل في النوافذ، ولا معنى للأبواب، في تجربة لينا شدود، سوى بإمكانية تحقيق "الخروج"، الآمن أو غير الآمن. أما أن يأتي الغائب من النافذة أو أن يحضر من الباب، فهذا ما لا تتوقعه الذات الشاعرة، المحاصرة من قديم في محبسها الانفرادي. والتحرر الأرحب، الذي ربما يتحقق في مراحل تالية من الانطلاقات المتوالية، فلربما يكون بالتحرر الذاتي، الداخلي، من كل ما يعتري الإنسان من قيود تسجن ملكاته وطاقاته وقدراته اللانهائية. تقول:
"أيتها النوافذ
أيتها الأبواب
ما أجمل الخروج منكِ..
ما أجمل الخروج عليكِ..
لن أفسّر لهم..
لن أفسر لكَ ارتطام النيازك لصالح النبوءة القديمة.
الرهان على قارّة نادرة،
يشبه طمع الغابة بخضرة أكثر حنكة.
أنا وأنتَ تأخّرنا في الخروج من الجلد،
لن نعرف كيف نعود"
لينا شدود، شاعرة ترى ذاتها جاءت في توقيت فارق، هو "تمام الدهشة"، هي تكاد تشك في كل شيء، إذ إن أصوات العالم تأخّرت، وثمة رمال تتحرّك، لتعتقل فرحة النجوم، لذلك فإنها تقف بعيدة، مصغية إلى لغة الوجود، ومرتقبة ضراوة الانبعاث. تقول:
"لا ريب أن هناك من سيوزع النور يومًا..
وفقًا للأرض..
وفقًا للسماء..
ريثما تُمهّد القلوب لضراوة الانبعاث"
وللتمرد ملمح مختلف، في تجربة صوت نسوي آخر، ينتمي إلى الشعرية العربية الجديدة، إذ ترسم الشاعرة التونسية هدى الدغاري في مجموعتها "ما يجعل الحب ساقًا على ساق" (نقوش عربية، تونس)، مدى للتحرك، وللتخييل، يتجاوز الأفق، وألوان قوس قزح. الفضاء الداخليّ للذات، هنا، يتناغم مع فضاء خارجي، لا سقف له، ولا قرار. الطيران في هذه التجربة له معنيان، الطيران بالأجنحة، وبالأفكار. ألوان الأجنحة ذاتها تتجاوز الحيّز الضيق لقوس قزح، لتقبض المخيلة على سماء مكتملة، فيما تتسع أدغال الروح لتتمشى فيها غابة إثر غابة.
في نصوص هدى الدغاري، تبدو الشعرية كأنها بإمكانها تسليم قرص الشمس تفاحًا، ينضج على وهجها. الإشعاع انطلاق دائم، يفيض حرية وتمردًا وجنونًا. حتى مدارات الجسد، تتسع لما يخرج عن التشهي المألوف، إلى منعطف ينتشي فيه العسل نفسه على خريطة الشفتين المعسولتين. تقول الدغاري:
"أبعد مني ومن ظلي،
رأيتُ ما فعلتْه مدنُ النمل،
واليرقات التي بدّلتْ أثوابها،
والفراشَ الذي نقع أجنحته في قوس قزح،
وسرب القبّراتِ المعتّقة بلون الظهيرة،
وطنينَ النحل،
بنشوة عسلٍ على شفتيّ..
عدتُ:
لم أزر غابة،
لم أتمّشّ في دغل،
فقط اكتشفتُ
كم غابة تتمشّى فينا"
أما العلاقة مع الآخر، الذي ربما يكون الرجل، فتتأسس في تجربة الشاعرة على ندية واضحة، وتكامل، بما يطلق العنان لبراحٍ جديد متسع، ناتج من تلاقي واشتباك إرادتين، ليتخلق ربيع لا تتهدده مخاطر الذبول. المشاركة، والإقدام، والإيجابية، والمبادرة، من ملامح تفاعل الذات الأنثوية مع الأخرى الذكورية، فالحب ليس ساقًا واحدة، بل هو ساق على ساق، وفراشات الفرح إن لم يكن لها وجود في الكون، فبالإمكان تخليقها، في لحظة يرتوي فيها النهر. هنا، الانطلاق يخلق وجودًا بأكمله، تقول:
"نهري عطشان،
لانسياب الكوب على شفتيكَ،
لفراشات فرح،
يطوّقن خصري..
بساتيني
لا تخشى صحوَ صيفكَ
على طراوة عشبي
من أجل ربيعٍ آخر
يأتي"
وإلى وجه آخر من وجوه التحرر، والرغبة في تجاوز السائد الجمالي، والراسخ المجتمعي، إذ تفتتح الشاعرة المصرية غادة خليفة حديثها، في مجموعتها "نسيج يستيقظ" (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة) بإشارة إلى مجموعة من أصدقائها المقربين، الحقيقيين والمتخيّلين، بوصفهم القادرين دائمًا على منحها الهدايا بقلوبهم قبل أيديهم. لكن هل تفي تلك المشاعر والهبات بالغرض؟ يبدو أنها غير كافية في بعض الأحوال، كأن تكون الهدايا ذاتها بغير أكفّ، والفراشات بلا أجنحة. الخيال هنا يمتلئ بالأنين، والشاعرة الحالمة بالحرية، ترى ما تتمناه، ربما، لدى امرأة أخرى. تقول:
"أصدقائي يكسِّرونَ خياليَ بِدأبٍ
يُحضرُ لِي أحدُهم فراشةً دونَ أجنحةٍ ويُخبرنِي أنَّها تَطيرُ بِخفَّةٍ
أمَّا الآخرُ فيأتي بزهورٍ منزوعةِ السِّيقان
ويطلبُ منِّي أنْ أضعَ لها السُّكرَ كي تعيشَ/
كلُّ الهدايا دونَ كُفوفٍ
خَيالي يمتلئُ فجأةً بالأنينِ
ويُخبرني أنَّ هديةً مكتملةَ الأصابعِ كانتْ ستختارُ امرأةً أخرى
بالتأكيد".
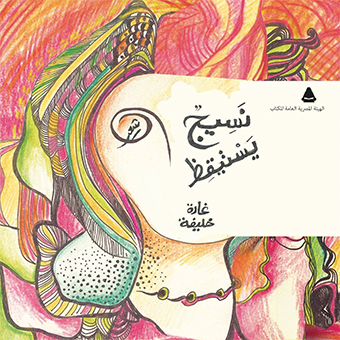
الكتابة، لدى غادة خليفة، كأنها خلاص موازٍ، تلجأ إليه الشاعرة، الراغبة في التواصل مع نفسها أولاً، أملاً في تصالح ما مع عالم الصمت والانزواء والفراغ. القصيدة دائمًا صيد ثمين، ذلك أنها تبلور الجوهر، وتكثف المعنى، وتنفض الغبار الزائل والزائف عن الأصيل الباقي. ماذا تريد الشاعرة من العالم؟ ما تريده هو: أن تظل تريد، وتريد، وتريد. الإرادة بحد ذاتها غاية، وهي الطاقة بعد فقدان الطاقة، والقدرة على إنقاذ غرقى بعد تحلل الذات. نعم، كل الكائنات التي تسبح في البحر الميت ميتة، لكن نفخة فيها من الروح المعطلة قد يكون لها تأويل مغاير. وتتسع دائرة الإرادة، شيئًا فشيئًا، ويصير "غير المسموح به" هدفًا للأمنيات والأحلام، وربما أيضًا للاختراعات، فما لا يمكن الوصول إليه بقدمي الحقيقة، وأجنحة المخيلة، وبساط الريح، يمكن خلقه أو اختلاقه، وحينها لن تخبر الشاعرة أحدًا في الصباح عن الحياة التي وجدتها، حتى لا يتهمها أحد بالكذب أو الجنون.
ولعل آلية "الاختراع" هي الملمح الأبرز في تجربة "نسيج يستيقظ" للشاعرة غادة خليفة، فهي لا تكتفي بابتداع اليقظة كانطلاقة معنوية، لكنها تؤلف النسيج ذاته تأليفًا من العدم، ولا يشغلها إن كان بإمكان أحد غيرها رؤية أو تصديق حدوتة الحياة، أم لا، طالما أن النسيج يكلمها أحيانًا، ويضحك لها، حتى ولو لم يدفئها. تقول: "لا تُوجدُ حدوتةٌ أصلًا، اخترعتُ الخيطَ الأولَ، وخيطًا مُهملًا بجوارهِ، أغزلُ نسيجًا لا يَراه غيري، النسيجُ يُكلِّمُني أحيانًا ويضحكُ لِي، مع ذلك ليسَ بإمكانِهِ أنْ يُدفئني".
ويأتي العشق ليكون بوابة التثوير، ولربما الجنون، في تجربة الشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس، فبقطرات من العشق، معسولة ومالحة في آن، مكثفة دائمًا، مسحورة بالضرورة، وببخور روحاني مصّاعد، لا يخلو من رماد الجسد المحترق بغير نار، تحاول الشاعرة استحضار ماردها العاصي، الذي لا يحضر، في طقس من طقوس الجنون الكامل. ولا يظل الصمت بطلًا للمشهد، إذ تتشكل الحروف من تلقاء ذاتها خارج المعنى المألوف. في مجموعتها الشعرية "على حافة عمر هارب" (دار البدوي، تونس)، يبدو البيت العاصم من الفتنة أوهن من خيمة، وأخف من غيمة، فكل النوافذ والأبواب، والحوائط أيضًا، مفتوحة على الريح، تلك التي يحرّكها العشق الجارف، في ملكوت ليس فيه سوى دين واحد، تفصح عنه الشاعرة صراحة في تقديم الديوان، مستحضرة عبارة ابن عربي "أدين بدين الحبّ أنّى توجّهت ركائبه".
ليس تناقضًا في نصوص "على حافة عمر هارب"، استسلام الأنثى لرهافتها المفرطة، وتسلحها في الوقت نفسه ببارود التمرد، الذي تستطيع بواسطته تفجير كل شيء: ذاتها، الرجل، مفردات العالم. تلك معادلة أولية من معادلات قصيدة فاطمة الزهراء بنيس، إذ يبدو افتتان الفراشة بألوانها غاية كبرى في حياة تلك الفراشة، لكنه لا يُنسيها أنها خُلقت أيضًا من أجل التحليق، والتجاوز، وربما التغريد أحيانًا بصوت طازج، مقطوف من رحيق الشِّعر.
إن المعنى يبقى دائمًا هو المعنى، لو أن الحياة المرجوة هي تلك الحياة المألوفة، التي يتلقاها الجميع، على علاتها، بدون إمكانية لتغييرها، أو محاولة صياغتها من جديد. أما الذات الشعرية، والأنثوية، والإنسانية، الطامحة إلى معنى خارج المعنى، فإنها لا ترى للحياة صيرورة إلا بتخليقها كما تتشهى هي، في تلك المسافة بين أقصى عمق للجذور، وأعلى سقف للرأس.
من غير هذا التوهج، الذي يسرق الرعشة من جثة الليل، تصير الأنفاس المتلاحقة، ويغدو توالد الكائنات، مجرد أفعال ميكانيكية، وحركات لا تتجاوز قاموسها الفيزيائي الضيق. هناك، في زبد البحر، يعيش اللامحدود. هناك، من فم الصحراء، تنطلق قُبلات عكس العدم. وإن تلك المغامرات، التي ترتادها الذات الشاعرة، بدهشاتها العاصية، ومراياها الفادحة، هي التي تشعل الحروف خارج المعنى، وتستدعي حياة أخرى خارج البرواز، ربما تبدو أكثر اتساقًا مع الخيال الشارد. بمثل هذا الاتقاد، يبدو كل عابر، حتى ذلك الضال، وذلك السائر نحو حتفه، حاملًا جوهر البقاء، وربما شعلة الخلود. تقول فاطمة:
"رسمتُ حياة خارجَ المعنى
وقبلتُ بغربة الجسد عن الجذور"
فاطمة الزهراء بنيس، شاعرة ولدتْ عريانة منها، بحد تعبيرها، لا تريد أن تشبه حوّاء، ولا أن ترضي آدم، الذي لجناحيه لذة الغرق. للإيحاءات المُشمسة تركت ذاتها، فاستدرجتها إلى عَتَه الصبا، حيث اللعب، والركض، والبوح، والضحك، والبكاء، والتلذّذ، والصعود، والسقوط، والموت، والانبعاث، وهكذا يكون الشعر.
أما الشاعرة المصرية منى لطيف، المقيمة في كندا، ففي مجموعتها الشعرية "قشور سكندرية"، الصادرة بالفرنسية عن دار "لارماتان" فى باريس، بعنوان: "ECAILLES ALEXANDRINES"، وتمت ترجمتها إلى العربية بمعرفة الدكتورة جينا بسطا، فإنها تبدو كأنما تكتب قصائدها من قلب غواصة مبحرة في مياه المتوسط، منذ الأزل. هذه الغواصة، عمرها من عمر البحر، بل لعها شقت الأرض قبل أن يشقها الماء.
الإسكندرية، مدينة العراقة، تتقصاها الشاعرة بأناة واصطبار، من زوايا مختلفة، بكاميرات دقيقة بانورامية، هي في الحقيقة "عيون أسماك أسطورية" تحفظ ذاكرة المكان، قبل أن يفتتح الإسكندر الأكبر صفحات التاريخ، وتتشكل خرائط الجغرافيا. أية بوصلة عثرت عليها الشاعرة في رحلتها المتمردة إلى عروس البحر؟ أم أنها، هي نفسها، عروس البحر، ارتدَّت من المجهول الأزرق، كي تجالس رواد المقاهي على كورنيش الإسكندرية العصرية، في الألفية الثالثة من عمر البشرية، وتسخر بطريقتها الخاصة من ضربات القدر، في انتظار مولد ضحكة؟ تقول منى لطيف في قصيدها الملحمي:
"أبناء البحر لا يهابون البحر
ولا صفير السفن
الراسية على الموانئ
بل يسبحون..
سوف أنتظرك
بمواجهة البحر
حتى انحسار الألم المرير
فأرى مولد ضحكتك
تبزغ من قلب البحر
يا ابن الإسكندرية"
الراوية العليمة، هنا، تؤمن بإسكندرية واحدة. إسكندرية البشر المسالمين، عشاق الحياة. ملتقى الأجناس من دول حوض المتوسط، راعية الحضارات، مهد الفنون، صديقة الصباح البريئة، رفيقة الجنون في الليل. إسكندرية ديوان منى لطيف، هي التي أقامها الغرب على ساحل الصحراء، والمقدوني عمّر أرضها بلغته وعقائده وثقافاته، ورواها بلعاب الأسلاف وبالحنين، إلى بيزنطة الدموية بقدر حسنها، ثم مددها كخصلة طويلة من الشعر، بطول الساحل الممتد على البحر. هذه المستحيلة، هي الإسكندرية، مدينة الروح والانطلاق.
"أيتها الإسكندرية الفتية..
هم يلوثونك
والبحر يغسلك"
ويبدو تجريب أنماط أخرى، غير الحياة، نهجًا للتحرر والتمرد في تجربة الشاعرة الجزائرية نوارة لحرش، ففي ديوانها "كمكان لا يُعَوّل عليه" (منشورات دار "الوطن اليوم")، تقترح الشاعرة ألعابًا أخرى بديلة عن لعبة الحياة غير مأمونة العواقب، وهي ألعاب خاسرة بالضرورة، لكنها تبدو محاولات لترك أثر ما، قبل تلف كل شيء، في وجودٍ عنوانه الوحيد "العدم". تقول:
"كلعبة سريعة التلف
آهلة بالعطب
نعبرها على عجل
نغادرها على عجل
كحشرجة منذورة لتفاصيل العدم
هي الحياة"
الشاعرة تدرك منذ البداية أن أي بناء إنما هو يُبنى للهدم، وأن المقدّس لا يعصمه من الزوال استثناء، لكنها لا تتخلى لحظة عن ألعابها، أو ألاعيبها، التي تواجه بها حقيقة أن الحياة (مؤنثة كانت أو مذكّرة) "مكان لا يُعوّل عليه"، تلك الحقيقة المؤلمة، التي تُعارض ما قاله المتصوف ابن عربي "المكان الذي لا يُؤنث لا يُعول عليه".
وهي، من البداية أيضًا، لا تكاد تلتفت إلا إلى الرحيل، فهناك منذ ذهبوا، وهناك من سيذهبون، لكن البقاء، ولو لفترة مؤقتة، يستدعي العرفان لمن تركوا بعد رحيلهم ثمرة أو رائحة أو حُزنًا. تقول في الإهداء: "إلى من رحلوا، وظلوا في القلب شجرة، مثمرة بالحنين والغصص".
من هنا، تعي الشاعرة نوارة لحرش أن لعبتها الأكثر قيمة، أو الأجدر بالتجربة، هي لعبة التحرر من أسر الحياة "الضيقة"، وخلق فضاءات بديلة للمعاني أرحب من كُنه الإقامة على هذه الأرض، والتمسّك بما لا يمكن التمسّك به. فسلالم الحياة، بالمعنى النمطي، ليست إلا وهمًا، ولا يقود صعودها إلا إلى هاوية. تقول:
"أتسلق عمري
عثرة عثرة،
وعند تخوم الخدوش،
أسقط متعثرة بخيبة عالية"
إنه "الضيق" الخانق، الذي لا يترك مجالًا لحراك: "كل هذا الأفق ضيق، وهذا الغيم قحل، والشتاء ضيق، والينابيع يباس، وهذي الرياح أرجوحتي، وهذي المواويل أنيني". ولا ملاذ للذات الشاعرة سوى استبطان جوهر جديد، خارج التأويل الاستهلاكي للمعنى. تقول: "في طيات المعنى، ثمة ملاذي".
وبقدر ما تسرد الشاعرة الكثير عن محاولاتها إيجاد "معنى جديد"، أو "حياة بديلة"، بقدر ما تلغي في عشرات القصائد والمقاطع أية قدرة إنسانية على فعل أمر ملموس في الحياة العادية، تلك الحياة التي "هي فقط مادة الإملاء"، والتي "لا تليقُ أيقونةً، أو خرزةً على صدر دميةٍ، مهملةٍ في تراب الذكرى". في الحياة المألوفة، السوداء بالضرورة، تبدو الظلال تحت الأشجار أكثر اسودادًا بالتأكيد. لكن ما تفعله الشاعره نوارة لحرش، التي تراهن على طيات المعاني، هو أن تُوجد في الحياة الأخرى، البديلة، التي تصنعها صناعة، ألوانًا أخرى للظلال، تحت شجر من طراز خاص، هو شجر الكلمات. هذا هو الإنبات الوحيد المتاح، الذي قد يُخلّف شيئًا ما في الأرض الخراب. نوارة لحرش، شاعرة تحررت بالقصيدة، بقدر ما منحت الحياة فرصة أخيرة، كي تصافح ذاتها الحقيقية، تحت شجر المعاني والكلمات.
وتنعكس تجليات الثورة النسوية لدى الشاعرة السورية بسمة شيخو، في أكثر من ملمح، ففي مجموعتها "شهقة ضوء" ("مركز التفكير الحر"، السعودية)، لا تفقد الشاعرة القدرة على الفعل، أي فعل، في حياة عنوانها الوحيد غير القابل للتأويلات هو "الحركة". منمنماتها الشعرية ذاتها يجوز التفاعل معها بوصفها بذورًا خصبة قابلة للنماء، نثرتها يدٌ صغيرة، لم تفقد إيجابيتها وإيمانها بدورها الكبير مع حلول صيحة القيامة. أما النجاة من الطوفان المحدق، فإن لها أكثر من وجه، ولربما تحققت النجاة بالتضحية بالذات، التي تتحول إلى جسر تعبر عليه ذوات أخرى إلى ضفة آمنة. تقول:
"أشعرُ بأنَّني أَستطيعُ الطَّيران
أتَجه للشُرفةِ وأحاول
لا بُدَّ هُنالكَ عَصافيرُ تَسكنني
أَرمِي نفسي في بِركة المـَاء
أحَاول أن أُنقذَ الأسماكَ داخلي"
بسمة شيخو، التي تشفق - ظاهريًّا - على الخفافيش اليتيمة من "شهقةِ ضَوءٍ ابتلعت الظُّلمة"، هي ذاتها التي لا تكتب إلا كي تحرر الضوء المحبوس في الفانوس السحري، لينهض من جديد كمارد أعرق من التاريخ، وأبقى من الخلود. تسمّي الشاعرة أحد نصوصها "ساحرة بالفطرة"، متكئة بالضرورة على "إن من البيان لسحرًا"، وإن حلت جماليات نص قصيدة النثر محل البيان المشار إليه.
ولأن الحالة لا تقتضي أي زخرف، تنتفي الحاجة إلى الفانوس السحري التقليدي، بأضوائه المشحونة من زيف زائل. القلب مصباح يتجدد، ولا يتبدد، والمارد يخرج مبتسمًا، بل ضاحكًا بصوت عالٍ، لأنه يعرف قيمة خروجه من "الفم"، على وجه التحديد، وحقيقة ما يمتلكه من كلمات ينثرها، فتتلون القصص والحكايات. تقول:
"لن أَحتاجَ لفَانوسٍ سِحري
سأفركُ قَلبي
ثمَّ أضحكُ بصَوتٍ عَالٍ
ليخرجَ المَاردُ من فَمي
مبتَسمًا"
وللتمرد حضوره الخاص في تجربة الشاعرة العراقية، المقيمة بالولايات المتحدة، دنيا ميخائيل، إذ تبدو الرسالة الأكثر خصوصية، التي تبعثها، هي تلك المقدرة الدائمة على بعث رسالة أصلًا، في عالم يوشك على الانتهاء. في مختاراتها الشعرية "أحبك من هنا إلى بغداد" (القاهرة، سلسلة "آفاق عربية"، الهيئة العامة لقصور الثقافة)، تقف دنيا ميخائيل على حافة العالم، الحرب من ورائها، واللاشيء من أمامها، لكنها لا تفقد القول. الحياة هي أن تحاول صناعة حياة، والتحرر من قبضة الموت لا يكون بخلود متوهّم، لكن ربما ببرقية خاطفة ترسلها وردة قادرة على التأريخ لكل شيء، حتى خرائط الخراب. تقول:
"شمّ الوردة وامضِ
إنها دائمًا تدري
أن العالم سينتهي بعد دقائق"

من منظور مغاير ترى الشاعرة ملامح الوجود، وحركة الكائنات، ثم إذ بها تبدو كأنها تدخر رسائلها للوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتكون كل رسالة حرفًا صغيرًا من حروف كلمة ضيقة، لكنها غير مستحيلة، اسمها "الحياة". هذا العالم الذي لا يتسع ولا يتمدد، ألا يمكن اقتسامه؟ وهذا الحلم بالتحرر، بل وبالطيران، ألا يمكن الاستعاضة عنه بأفعال صغيرة، لكنها مقدور عليها، من قبيل الارتباك، وهز الأجنحة المهيضة على سطح الأرض المهيضة بدورها؟ تقول:
"نقتسم العالَـمَ
خبزًا
أو مطرًا
أو معطفًا كبيرًا علينا
ونرتبكُ
لأننا
- ولو نهزّ أجنحتنا -
لا نطيرُ"
أي جدوى للإصرار على التشبث بطوق نجاة، والبحر ذاته يغرق؟ تلك خصوصية الشاعرة، التي لا تزال عاشقة للنوافذ، رغم عدم ثقتها بالسماوات. تقول دنيا:
"يريد أن يجلس جوار النافذة،
ليتأكد أن السماء
هي نفسها في كل مكان"
وللانطلاق حضور لافت في مجموعة الشاعرة المغربية علية الإدريسي "هواء طويل الأجنحة" (دار التوحيدي، المغرب)، ففي التفاتة مبدئية للعنوان، تتجلى انطباعات يصعب الانفلات من أسرها عند الاستغراق في قراءة النص، فهناك "هواء"، وهناك "أجنحة"، وهذه الأجنحة تتسم بـــ"الطول" كصفة وحيدة. إنه الفضاء اللانهائي، بل هي "قوة تحرر ثلاثية"، يطلقها العنوان المحلّق. علية الإدريسي، الشاعرة، والمرأة، تحتمي بالبراح وهي تكتب، مثلما أنها تأبى الكمون والسكون وهي تحيا. أما إذا وَرَدَ، ولو في الخاطر حتى، حديثٌ عن "أسْرٍ"، أيِّ أسْرٍ، فإنها تحفر بآلياتها الخاصة أنفاقها السرية، ليس فقط إلى بطن الأرض، بل إلى عطر الورود، ونجوى النجوم، وأعماق البحار. تقول الشاعرة:
"هكذا...
هكذا دائمًا
أراقب جموح الريح
تحملني مثل ثلاث جثث
تزفني إلى تويجات الورد...
ذيلُ السمكة يصفق
يصفق قليلاً،
هكذا يصفق ثم يطلق
سراحي".
هي، كشاعرة هامسة، وامرأة من ضوء وماء وذرات تراب، تدرك أنه لا سبيل لتحاشي الانكسار، مثلما أنه لا سبيل لتفادي الطوفان، وقد انصرفت سفينة نوح من قديم. إن بذرة واحدة فقط قد تصلح لإنبات الحياة، والتي تقول لصغيرها "كم الساعة الآن، فأنا فاتني أن أكون الشجرة؟"، تصعد من جديد برهانها على النادر، الاستثنائي، لكنه ليس أبدًا المستحيل. تقول:
"بدلفين واحد/
وجذع مكسور مني/
أصعدُ
إلى
الحياة"
هي لعبة الحضور بعد الغياب، تليها لعبة الغياب بعد الحضور، تلك هي الحياة بعنفوانها وبهجتها، في مواجهة موت لا ييأس، ولا ينضب معينه. لا معنى للوقت، طالما أن الذات الشاعرة تتحرك بعجل، أملاً في بلوغ سرعة تتعاظم فيها الكتلة، ويتوقف عندها الزمن، ولربما يطل الخلود من طاقة سحرية، لا يعلم أحدٌ عنها شيئًا إلا في الأحلام. علية الإدريسي، شاعرة تتحرر بقصائدها، في هواء هي التي تصنعه، محلقة بأجنحة من نسجها الخاص. وهي تدرك دائمًا أن المعنى الباقي للضحكة، هو القدرة على صياغة تلك الضحكة.
وتتجلى ملامح التمرد، والرغبة في التحرر والانطلاق، في مجموعة "يشدني المكان.. يكسرني العطر"، للشاعرة اللبنانية جميلة عبدالرضا (دار النهضة العربية، بيروت)، فـ"الصعود" هي الكلمة الأولى التي تستهل بها الشاعرة قصائد المجموعة، إذ لا إطار يحكم المشهد، مثلما أن الحياة برمتها يجب ألا تخضع لقوانين وقيود. تقول جميلة عبدالرضا:
"أصعدُ مني كطيفٍ
كنهر متعرج
أزدادُ نحولًا كلما تُقتُ إليك
أنكسرُ في الضوء
وأرتعش في موازيني
كلما من أقصاي إلى أدناي
تماديت"
وفي وحدتها، تستعين الذات الشاعرة بالآخر، وبالقصيدة، وبالعشق. رفض الأمر القائم، هنا، يتجاوز الاعتراض عليه، إلى أمر أكثر إيجابية، هو خلق وضعية جديدة أو متنفس يليق بالرئتين. بالكلمات مثلًا، وهي أضعف الإيمان، يمكن أن يصير الخواء حريرًا، وأن تحتشد الغزلان في مطلع الشفاه. هكذا لا يمكن للدروب أبدًا أن تؤجل مجيء المدن. تقول الشاعرة:
"ما زلتُ وحيدة
رغم الشعر
رغم العصافير المنفلتة
بين عينيكَ وعينيّ
ورغم البراري المحرّضة للقصائد
ما زلتُ وحيدة كسنونوة زرقاء
كلما قطفتُ سماء مسقوفة
يسكبني الحبُّ شلالًا
على السطر".
تغريد




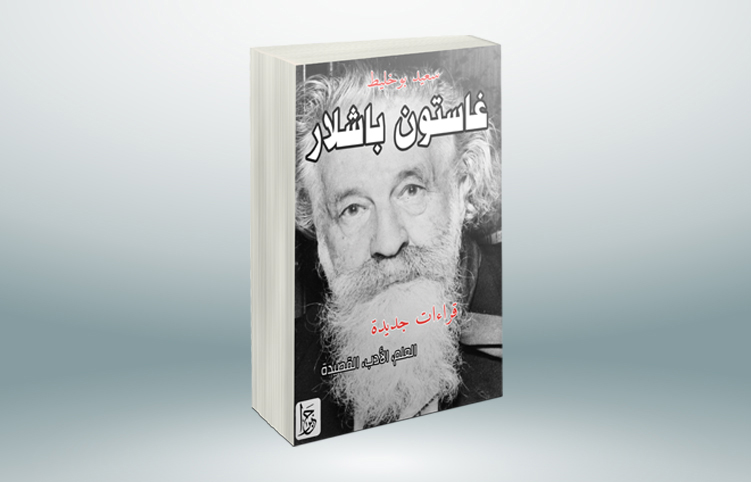

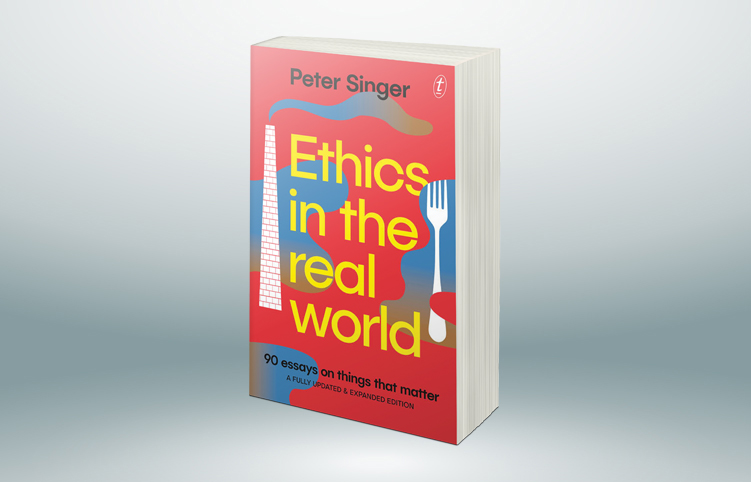
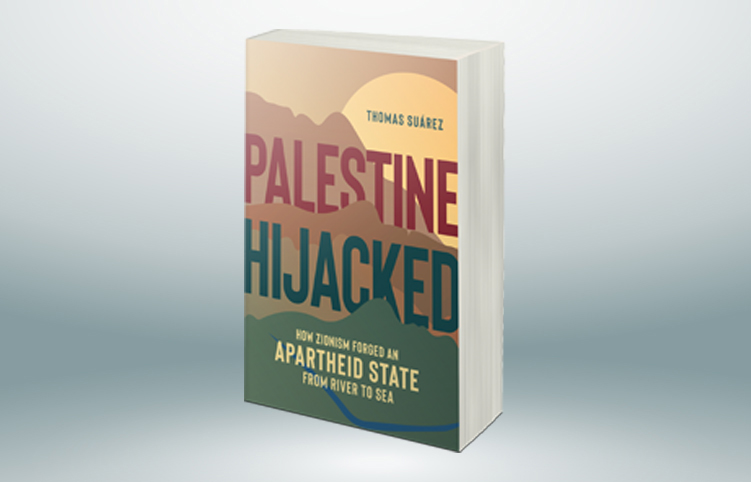


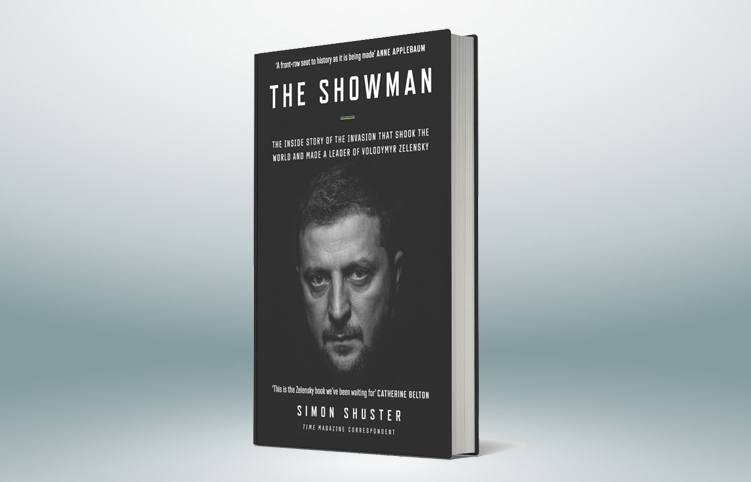






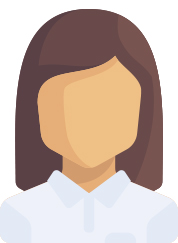
اكتب تعليقك