ظاهرة الانغلاق والانفتاح في الخطاب الإسلامي نماذج من الفكر الإسلاميالباب: مقالات الكتاب
 | د. عبد الله رمضاني المغرب |

لا ريب أن الناس يتباينون في رؤيتهم نحو الآخر، أيًّا كان نوع هويته وطابعها، وفي كيفية تعاملهم معه. والعقول في هذا الموضوع تتراوح بين موقفين هما على طرفي نقيض: فإما انغلاق عام وشامل، أو انفتاح أبعد في مداه.
فالمنغلق ينظر إلى الآخر ويحاكمه من زاوية هويته الدينية، أو القومية اللغوية، أو الحضارية الثقافية...فإن اتفق معه على أساس العقيدة أو المذهب أو العرق أو الثقافة أو النمط الحضاري، تماهى معه وقبله، وإلا رفضه بدافع أنه يمثل البدعة في الفكر، أو العمالة والخيانة، أو التأخر والتخلف، أو أي اسم آخر يدل على المغايرة الكلية أو على الاختلاف القاسي.
فالمفكر المنغلق على ذاته ومعتقده يقصي الآخر، وينكر حقه في أن يختلف معه، ومسوغ ذلك في نظره أن اختلاف الآخر عنه هو نقيض الهوية وعكسها الذي يعاديها ويعمل على إخضاعها أو استئصالها. وعلى سبيل هذا المقتضي يصير الآخر في نظره لا حقوق له كإنسان. هكذا ينبذ المفكر المنغلق المنزوي في يقينياته المطلقة وتصنيفاته الضيقة، كل اختلاف أو مغايرة، علمًا أن الاختلاف المناقض القاسي هو الوجه الآخر للهوية النقية العشواء، بل هو علة وجودها وكينونتها ومبرر ترابطها وتلاحمها.
وفي المقابل، نرى المنفتح ينظر إلى غيره من أصحاب الهويات الأخرى، نظرة مخالفة، فيتقبله ويرضى به، ويرى فيه عنصرًا مكمّلاً أو مشابهًا، وقد يتمازج معه ويتقارب، بالرغم من الفوارق اللغوية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية...ذلك أن الآخر من خلال هذه النظرة المنفتحة، لا تستنفده هوية معينة ولا تستهلك وجوده صفة خاصة...بل يملك هوية مركبة واسعة، لها أبعاد متنوعة، ووجوه متعددة...
ولا يخلو معتقد أو مذهب أو جماعة ثقافية من صنف من هذين الصنفين. بيد أن ذوي العقول المنغلقة يشكلون الأكثرية الغالبة. بينما أهل العقول المنفتحة يمثلون الأقلية النادرة، ولعل الواقع المعيش بمختلف مجالاته العقدية والثقافية والحضارية وغيرها خير دليل على ذلك.
فيما يتعلق بالاتجاه الانغلاقي هناك سلسلة متوالية تبدأ بأصحاب النص والخبر وتشمل أعدادًا غفيرة من العلماء الكبار من العصر القديم كالغزالي والبغدادي وابن تيمية وغيرهم...لكي تنتهي في العصر الحديث بعدد من المفكرين والعلماء على تباين تسمياتهم وانتماءاتهم أمثال علي سامي النشار ومحمد تقي المدرسي ومن سار على شاكلتهم...
أما الاتجاه الانفتاحي فمن أبرز ممثليه كابن رشد وابن عربي والشريف الرضي... قديمًا، ومصطفى عبدالرزاق ومحمود قاسم...حديثًا. وقد اكتفيت بذكر بعض النماذج البارزة، وإلا فالأسماء كثيرة داخل كل اتجاه.
ويلاحظ من خلال التصنيف السابق للعلماء والمفكرين والمندرجة أسماؤهم تحت كل اتجاه، أن بينها فوارق فكرية وعلمية واجتماعية خاصة بين القدماء والمحدثين، فهم ينتمون إلى سلالات فقهية وكلامية متباينة. بالرغم من ذلك فقد حاولت تصنيفهم انطلاقًا من التمييز بين نموذجين عقديين: منغلق ومنفتح، ولكل نموذج أماراته أيًّا كانت أصوله الكلامية واجتهاداته الفقهية، وهويته الاعتقادية سنة كان أم شيعة. فهم في تصوري ينتمون إلى عقلية واحدة، ويشكلون جميعًا نمطًا وجوديًا واحدًا مهما كانت اتجاهاتهم الفكرية وانتماءاتهم العقدية أو المذهبية. وكما يلاحظ هنا أن التصنيف المعتمد يخالف تصنيف أهل الملل والنحل، وإنما هو تصنيف أنطولوجي ينبني على أساس التمييز بين موقفين من الحقيقة ومن الذات ومن الآخر: إما انغلاق على الذات وإقصاء لوجود الآخر، وبالتالي اعتبار الأنا مصدر كل علم ومعرفة، وإما انفتاح على الآخر والاعتراف بنصيب حقه في الوجود، ويستتبع ذلك التفاعل معه والإفادة منه.
ولتوضيح ما تقدم، سنحاول ضرب بعض الأمثلة لمواقف كل من الاتجاهين السابقين، ونبدأ بالاتجاه الأول.
فالغزالي (450هـ- 505هـ/ 1058م- 1111م) يعتبر من الأوائل الذين كان لهم موقفًا عدائيًا وسلبيًا من الفلاسفة، وردّ عليهم بشكل منهجي منظم، علمًا أنه أفاد كثيرًا باطلاعه على علومهم وأبحاثهم الفلسفية، ولكنه، ومع ذلك، حمل عليهم وبدّعهم وكفّرهم بدعوى أن آراءهم وأفكارهم الفلسفية تخالف أصول الإسلام. ولم يقتصر موقفه العدائي على العلوم الإلهية، بل تعداه إلى علوم حيادية ليست لها علاقة في حد ذاتها بالدين نفيًا أو إثباتًا كالعلوم الرياضية، بذريعة أن لها تأثيرًا خدّاعًا على الدين، لأن من يطلع عليها، وهي ما تتميز به من الإحكام والوثوق، يحسن اعتقاده في الفلاسفة ويكفر بالتقليد. فقد نظر إليها الغزالي على أن كثيرها مذموم لما تؤدي إليه من الشك أو الإلحاد(1).
بالإضافة إلى ذلك فقد كان الغزالي من أتباع الموقف الصوفي المضاد للفلسفة. وكان يقول ما فحواه: لا يوجد قانون سببية يتحكم في الطبيعة كما يزعم الفلاسفة، وإنما توجد فقط إرادة الله، فهذه الإرادة هي التي تتحكم بكل ظواهر الطبيعة، وبالتالي ينبغي على العلم أن ينحسر أو ينسحب في الساحة أمام عظمة الدين. ولعل هذا الموقف شبيه بموقف اللاهوتيين المسيحيين أيضًا، فهم لا يثقون بالعقل ولا بالعلم، وإنما فقط بأقوال آباء الكنيسة ورجال الدين(2).
أما ابن تيمية (661ه- 728ه/ 1263م- 1328م) فقد أكد جازمًا أن (العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علمًا، وما سواه إما أن يكون علمًا فلا يكون نافعًا، وإما أن لا يكون علمًا وإن سمي به، ولئن كان علمًا نافعًا فلابد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه) (3).
وفي موضع آخر يقول ابن تيمية في حق كل من الفارابي وابن سينا، مع علو قدرهما ومكانتهما: (طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ونحو هؤلاء) (4).
والإشكالية أنّ كل من يتخذ من تراث الشيخ ابن تيمية مرجعًا مقدسًا لحل معضلاته، وملاذًا للإجابة عن إشكالاته، كما هو الحال لدى القطاع الكبير من الناس، بحيث يجعل ما تكلم به عن غيره من المناهج، أو ما تكلم به عن الأشخاص هو الخلاصة والحق الذي ينبغي تقليده، ولا يمكن العدول عنه، وكأنه وحي ثان.
وفيما يتعلق بتقي الدين أبي عمرو الكردي الشافعي المعروف بابن الصلاح، مفتي الشام ومحدِّثها، توفي بعد عام 643 هـ/ 1245م، فقد أفتى بأن (الفلسفة أسّ السّفه والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان. وأظلم قلبُه عن نبوة محمَّد صلى الله عليه وسلم ...وأما استعمال الاصطلاحات المنطقيَّة في مباحث الأحكام الشرعيَّة من المُنكَرات المستبشَعة، والرَّقاعات المستحدَثة، وليس للأحكام الشرعيَّة- ولله الحمد- افتقارٌ إلى المنطق أصلًا... ومن زعم أنَّه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به. فالواجِبُ على السلطان أعَزَّه الله أن يدفَعَ عن المسلمينَ شَرَّ هؤلاء المشائيم، ويخرِجَهم من المدارس ويُبعِدَهم...)(5).
وقد سلك عبدالرحمن ابن خلدون (ت: 808ه/ 1406م)، المفكر الكبير ومكتشف علم العمران، نفس مسلك سابقيه، بحيث وقف هو الآخر موقفًا سلبيًا من الفلسفة وأصحابها، وتكلم عن نقائصها وانعكاساتها الخطيرة على الدين والعقيدة.
كما نراه يفنّد الفلسفة، ويرسم صورة سلبية لها، وقلّل من أهميتها؛ فهو يرى (أن ضررها في الدين كثير فوجب أن يُصدع بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها)(6). كما انتقص من قيمة أرسطو وسخر من متتبّعيه بقوله: (ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق)(7). كما انتقد من اقتنعوا بنظريات وأفكار الفلسفة اليونانية وبآراء أرسطو ومن حذا حذوه فقال: (ثم كان من بعده في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتَّبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل إلا في القليل، وذلك أن كتب أولئك المتقدمين؛ أي فلاسفة اليونان، لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني تصفحها كثير من أهل الملَّة وأخذ من مذاهبهم من أضلَّه الله من منتحلي العلوم، وجادلوا عنها، واختلفوا في مسائل من تفاريعها، وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي … وأبو علي بن سينا … وغيرهما. واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه)(8). إضافة إلى ذلك انتقد الأبحاث الفلسفية بشكل عام، ولم ير لها فائدة تذكر؛ ذلك أن الماهر من المتفلسفة يظل (عاكفًا على كتاب "الشفاء" و"الإشارات" و"النجاء" وتلاخيص ابن رشد للقص من تأليف أرسطو وغيره يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينها ويلتمس هذا القسط من السعادة فيها ولا يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع عنها، ومستندهم في ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعَّال واتَّصل به في حياته فقد حصَّل حظه من هذه السعادة)(9). وبناء على ذلك صبّ ابن خلدون جام نقده على ابن سينا وقلَّل من شأنه في رئاسة المتفلسفة، بل اعتبر الفلسفة مناقضة للشريعة، ولم يعترف ابن خلدون للفلسفة إلاَّ بمهمة بتقوية الذهن وتنشيطه في ترتيب الحجج والأدلة قصد اكتساب أجود البراهين والتمكن من أصحها. أما الاطلاع على مباحثها ومقولاتها، فلا يراه ابن خلدون يحقق تلك الفائدة الجزئية (إلاَّ بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على العلوم الإسلامية الأصيلة كالتفسير والفقه ولا يكبنّ أحد عليها وهو خلوٌ من علوم الملة، فقلّ أن يسلم لذلك من معاطبها)(10).
ولعل فيما ذهب إليه ابن خلدون، سابقًا، نوعًا من الازدواجية بين عقلانيته العلمية من جانب، وبين توجهه الاعتقادي الأشعري، وليس الإسلامي، من جانب آخر. لأنه لا يمكن لأي مذهب أو معتقد احتكار الإسلام، أو بالأحرى امتلاك الحقيقة القرآنية. إذ القرآن نص مفتوح على الجميع، ولا يمكن لأي مذهب أو تفسير أن يستفرغه، أو يغلق الأبواب في وجه الجهود الأخرى المبذولة في فهمه. فلكل تصوره وفهمه، ومن ثم مذهبه وإسلامه. بيد أن الاتجاه العقدي المنغلق يسعى إلى احتكار المعنى، وامتلاك الحقيقة في النص، زاعمًا أن إسلامه هو الإسلام الوحيد والصحيح من دون سواه.
ولهذا فإنه إذا كانت تلك المواقف المستعرضة سابقًا، لم تتسع لأصحاب الديانات والثقافات الأخرى، فإنها لم تتسع لأهل المذاهب الأخرى داخل الملة الإسلامية نفسها. ومهما يكن الأمر فإن موقف أصحاب الاتجاه الأول المنغلق لا يتماشى والفطرة السليمة، فهي تسعى بطريقة أو بأخرى إلى مصادرة العقل لحساب المعتقد المذهبي والتقليد، علمًا أن النص القرآني لا يؤيدها، بل هو نصّ دعا، في مواضع كثيرة من التنزيل الحكيم، إلى إعمال الفكر والنظر والاعتبار، وهو أشمل وأوسع من المذاهب التي تزعم أنها قادرة على تفسيره والوقوف على مراده دون الآخرين. ولعل هذه الدعوة القرآنية نجد صداها في العصر الحديث عند رائد الفلسفة الحديثة، ديكارت، في بداية كتابه "خطاب المنهج" حيث يقول: (العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس)(11).
وعلى النقيض، يقف أهل الانفتاح من ثقافات غيرهم وعلومهم موقفًا وسطيًا وليس عدائيًا. ويعتبر أبو الوليد ابن رشد الحفيد (520هـ- 595هـ/ 1126م/ 1198م)، الفقيه والقاضي والفيلسوف، من أبرز من يمثل هذا الاتجاه المنفتح. فقد تميز بموقفه المرن والسمح والعقلاني من العلماء والمفكرين المسلمين، فهو يعتبر الاطلاع على علوم الآخرين من الأمم السالفة واجبًا بالشرع، ما دام ديننا الحنيف يدعونا إلى استعمال عقولنا للبحث في كلّ المجالات التي خاضت فيها الإنسانية... ويشترط مع ذلك التسلُّح بالمنهج العقلي البرهاني في فحص ما نطَّلع عليه من علوم الآخرين، لنقبل النافع منه ونرفض المخالِف للحقِّ والصَّواب. وفي هذا السياق يقول ابن رشد: (فقد يجب علينا إن ألفينا لمن تقدَّمنا من الأمم السالفة نظَرًا في الموجودات واعتبارًا لها بحسب ما اقتضته شرائِطُ البُرهان، أن ننظُرَ في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها مُوافِقًا للحقِّ قبلناه منهم وسُرِرْنَا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غير مُوافق للحقِّ نبَّهنا عليه وحَذِرْنَا منه وعذَرْناهم. فقد تبيَّن من هذا أنّ النَّظَر في كتب القدماء واجب بالشرع، إذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم، هو المقصد الذي حثَّنا الشرع عليه)(12).
ومن الدواعي التي جعلت ابن رشد يرى ضرورة الاعتماد على علوم الآخرين، أنه ليس بمقدور أيِّ أحد سواء كان فردًا أو أمة أن يتقدم في هذه العُلُوم ما لم يستفد مما وصلت إليه جُهود الآخرين وتراكمات عطاءاتهم. فلا بُدّ، حسب رأيه (أن يستعين في ذلك المتأخِّر بالمتقدم)(13).
ولعل هذه الرؤية الإنسانية الواسعة التي اتسمت بها فلسفة ابن رشد، والمستمدة من جوهر الدعوة الإسلامية الذي يخاطب الإنسان باعتباره إنسانًا بغض النظر عن أصله ولونه ولسانه، هو ما جعل الأوروبيين - بعد وفاة ابن رشد – باختلاف مللهم ونحلهم، يُقبلون بولع شديد على الفلسفة الرشدية التي كانت تشكّل، إضافة إلى نواحٍ أخرى من الفكر الإسلامي، أهم الأسس التي ساعدت على نهضة المجتمعات الغربية من سباتها العميق.
ونظير ابن رشد أبو النصر محمد الفارابي، رغم الفارق الزماني بينهما، فهو يعد واحدًا من أبرز الفلاسفة المسلمين، وكان ينظر إليه على أنه أعظم سلطة فلسفية بعد أرسطو، وكان يلقب بالمعلم الثاني، واشتهر بإتقان العلوم الحكمية وكانت له قوة في صناعة الطب (260هـ- 339هـ/ 874م- 950م). قد صدر عن رؤية أكثر انفتاحًا على ثقافات الغير. بحيث أن الفارابي لم يكن موقفه منطلقًا من أساس شرعي فقهي، ولم يكن في خطابه مصرحًا بانتمائه إلى ملة من الملل. فهو إن كان له انتماء فقد انتمى إلى الفلسفة وانحاز إليها. غير أنه كان إضافة إلى ذلك أكثر انفتاحًا من سلفيه وأستاذيه أفلاطون وأرسطو. ولذلك فهو لم يفاضل بين الأمم والديانات، بل اعترف بوجود أمم كثيرة فاضلة، وأكد أنه توجد أكثر من ملة فاضلة.
أما محيي الدين بن عربي (558هـ- 638هـ/ 1164م- 1240م)، الذي يعتبر واحدًا من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين على مر العصور، فنراه في بعض مؤلفاته يحذر كل مشتغل بالعلم أن يبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو متكلم ويقول هذا مذهب الفلاسفة أو المتكلمين، فإن هذا القول في نظره لا تحصيل له، إذ ليس كل ما قاله الفيلسوف مثلاً باطلاً )فعسى تكون تلك المسألة فيما عنده من الحق ولا سيما إن وجدنا الرسول عليه السلام قد قال بها، ولا سيما فيما وضعوه من الحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سوء الضمائر، فإن كنا لا نعرف الحقائق ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسألة المعينة وأنها حق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بها أو الصاحب أو مالكًا أو الشافعي)(14).
وفي موضع آخر من كتابه "الفتوحات المكية" نجده يرد بقوة على من يدعي أن الفيلسوف لا دين له قائلاً:)وأما قولك إن الفيلسوف لا دين له فلا يدل كونه لا دين له على أن كل ما عنده باطل، وهذا مدرك بأول العقل عند كل عاقل، فقد خرجت باعتراضك.... في هذه المسألة عن العلم والصدق والدين، وانخرطت في سلك أهل الجهل والكذب والبهتان ونقص العقل والدين وفساد النظر والانحراف..)(15).
وفي نفس الكتاب نراه ينتقد من يكره أفلاطون من أهل علماء زمانه قائلاً: (...وما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة...والفيلسوف معناه محب الحكمة لأن "سوفيا" باللسان اليوناني هي الحكمة وقيل هي المحبة، فالفلسفة معناه حب الحكمة، وكل عاقل يحبّ الحكمة...)(16).
وقد ذهب ابن عربي، بخطوات أوسع وأكثر جرأة، بعيدًا إذ رأى الحق في كل صورة، وتماهى مع كل معتقد، متهما بالجهل كل ذي معتقد يتعصب لمعتقده، كما عبر عن ذلك في الفص الأخير من كتابه "فصوص الحكم" وهو الفص المخصص للنبي العربي، حيث قال: (وإن شئت قلت القدرة فمؤنثة أيضًا، فكن على أي مذهب شئت، فإنك لا تجد إلا التأنيث يتقدم حتى عند أصحاب العلة الذين جعلوا الحق علة في وجود العالم، والعلة مؤنثة.)(17).
وإذا انتقلنا من القدامى إلى المحدثين والمعاصرين نجد أن هؤلاء يعيدون إنتاج المواقف القديمة ذاتها، ولكن بصورة هزيلة وتقليدية تخلو مما لدى القدماء من الجدة والابتكار والأصالة.
نعرض لموقف كل من علي سامي النشار (1917م – 1980م) ومحمود قاسم (1913م- 1973م). وهما مصريان كلاهما أستاذ للفلسفة وباحث في الفكر الإسلامي. فالنشار يذهب إلى أن للإسلام فلسفته بل ميتافيزيقاه الخاصة الأصيلة التي نشأت على أرضه والتي لا علاقة لها بفلسفة اليونان ولا بفلسفة المسلمين كالكندي والفارابي وابن سينا. ولهذا فهو يرفض أن يسمى النتاج الذي تركه هؤلاء فلسفة إسلامية كما يرفض الفلسفة جملة وتفصيلاً، بحجة أنها معادية للإسلام، مناقضة للميتافيزيقا التي وضعها القرآن. هكذا فأستاذ الفلسفة يقصي من دائرة تفكيره القطاع الفلسفي في الثقافة الإسلامية، معتقدًا أن هناك فلسفة إسلامية أصيلة صافية يمثلها علم الكلام وحده. ولكنه لم يجد وسيلة للتعبير عن هذه الفلسفة المزعومة إلا باستعمال ألفاظ يونانية معربة كلفظ ميتافيزيقا ولفظ فلسفة ذاته.
فكم كان المفكر علي سامي النشار، رحمه الله، قاسيًا على هؤلاء المتفلسفة من شراح أرسطو ومقلديه؛ فهو يرى أن نموذجهم المصبوغ بصبغات اليونان والفرس وبصبغة الغنوص ليس أبدًا فلسفة إسلامية. فمن يجرؤ، بنظره، على القول إن الفارابي كان فيلسوف الإسلام؟ أو إن ابن سينا يمثل الفلسفة الإسلامية في شيء؟! ولعل ابن رشد، برأيه، كان أكثر أصالة من هؤلاء وأكثر نفاقًا؛ فقدم مذهبًا مسلمًا في بعض كتبه، ومذهبًا يونانيًا في البعض الآخر(18).
والأمر لم يقتصر على الدائرة السنية فحسب، بل نجده يطال حتى الدائرة الشيعية، حيث تتعارض المواقف من ثقافات الآخر وعلومه. فنجد مثلا أن باحثا إسلاميا كمحمد المدرسي يقف موقفا عدائيا ومشابها لموقف علي سامي النشار، إذ هو يقرر بأن الإسلام يستبعد الفلسفة والتصوف كمنهج وسلوك ورؤية، ويعتقد بوجود ثقافة إسلامية صافية يجب تبينها والدفاع عنها في مواجهة الآراء والتصورات الضالة الوافدة عليها سواء من الفلسفة اليونانية القديمة أو من الثقافة الغربية الحديثة. ولهذا يمتنع هو الآخر إطلاق اسم "فلسفة إسلامية" أو "فلسفة الإسلام" على ما أنتجه الفلاسفة المسلمين، ويشجب التصوف وأهله مستدلاً بأقوال تصنف الذين يميلون إلى الفلسفة والتصوف ضمن دائرة شرار الخلق(19).
وفي المقابل نجد أن المفكر الإسلامي محمود قاسم رغم انتمائه للإسلام لم يمنعه ذلك من الانفتاح على الفلسفة وإنصاف أهلها والانتصار لهم، وبخاصة ابن رشد الفيلسوف الذي افتريت عليه العديد من الأقاويل والادعاءات(20).
ويعاضد نفس هذا الموقف عالم كبير من علماء الإسلام يحسب على المذهب الشيعي هو محمد حسين الطباطبائي (1904م- 1981م)، إذ لم يمنعه انتماؤه العقدي واشتغاله بعلوم الشريعة والكلام من النزوع إلى الفلسفة والاهتمام بها والثناء على الفلاسفة المسلمين، وأخصهم بالذكر الفيلسوف الشيرازي الذي تعرض لنقد لاذع من قبل المدرسي(21).
إجمالاً، فصاحب الرؤية المنغلقة لا يجد إمكانًا للتلاقي مع الآخر، بينما صاحب الرؤية المنفتحة يعمل جاهدًا دائمًا في أن يكتشف في أي شخص وجهًا يتقاطع به معه، أيًّا كان ابتعاده عنه. فالبشر يتقابلون ويتواصلون وإن لم يشاءوا. وليس من المستبعد أن نكتشف فيما نختلف عنهم وجوهًا تجمعنا بهم. فما من امرئ نسوء الظن به إلا ويتضح أن له وجهه المشرق والحسن، والعكس صحيح.
بناء على ما سبق، بوسعي القول إن هذا التمييز الذي وضعته بين الاتجاهين: الانغلاق والانفتاح، يظل نسبيًا، وأمرًا اجتهاديًا، ولا يعني ذلك أنني أرجح كفة الانفتاح ابتداءً، بل إنني أنظر إلى الذين انفتحوا على ما عند الآخر من علم ومعرفة وحكمة باعتبارها نتاج عقل بشري يقبل الأخذ والرد، ونفس الأمر بالنسبة للذين انغلقوا على ثقافتهم، فإني لا أرد كل ما أنتجوه أو ما قالوه، بل أنفتح عليهم وأفيد منهم، علمًا أن بينهم علماء كبارًا لهم حضور قوي على الساحة الفكرية والعلمية والمعرفية.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أهم السمات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها الخطاب الإسلامي، نذكر منها ما يأتي:
• الموضوعية العلمية، فأي خطاب كيفما كان نوعه وطبيعته لن يكتب له الاستمرارية إذا لم يتصف بالموضوعية وترجيحها على كافة الذات. ففي نطاق البحث العلمي أو المعرفي من الضروري توافر هذه السمة، فهي تأشيرة المرور إلى عقول العلماء والمفكرين والمثقفين.
• التواضع العلمي، وهي صفة رئيسة يجب أن تقرأ على صفحات الخطاب الإسلامي، فالتعالي وادعاء امتلاك المعرفة من ناصيتها والتعصب الفكري يجعل أي خطاب محكومًا عليه بالإعدام ابتداء، إذ العقول السليمة والطباع النقية تنفر عادة من مثل هذا الخطاب وتمجّه. فالحقائق المتوصل إليها تظل نسبية وقابلة للخطأ مادام العقل البشري منتجها.
• التواصل الإيجابي البناء هو الذي يكسب الخطاب الإسلامي قوته ومصداقيته وقيمته. لذا، يتعين عليه أن يبني جسرًا سميكًا وصلبًا من التواصل أساسه ولحمته الحوار البناء، والبحث عن الحقيقة بروح التعاون والتسامح والتفاهم برغم ما قد يحصل من جراء ذلك من اختلاف وتباين في الآراء والأفكار والتصورات.
• الانصاف والاعتراف بحق الآخر، وتقبل أفكاره وآراءه وعدم الانتقاص من قيمتها وأهميتها.
• النقد الذاتي، وهو ضرورة ملحة في الخطاب الإسلامي، فهو صمام الأمان لكل ما يعرض ويكتب وينشر، وعبره يكسب هذا الخطاب سيرورته العلمية والمعرفية والثقافية.
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمبادئ العليا، والتحلي بالروح السامية المتسامحة، واستحضار المعاني النبيلة والعالية لرسالة الإسلام واستثمارها في خطابنا العلمي والمعرفي والثقافي. والإسهام في نشر قيم ثقافة الإنساني الفكري والمعرفي بين مختلف الثقافات والأوساط العلمية العالمية.
الهوامش:
1 - ينظر كتاب "المنقذ من الضلال" تقديم وتعليق وتحليل عبد الحليم محمود- دار الجيل بيروت- ط1/ 2003- ص: 68 وما بعدها بتصرف.
2 - "البيان": الفلسفة في القرون الوسطى- جون مارينبو أغسطس 2005.
3 - "مجموع الفتاوى" لابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 2004 - 10/664.
4 - المصدر نفسه، 8/ 195.
5 - ينظر كتاب فتاوى ومسائل ابن الصلاح تحقيق عبدالمعطي آمين قلعجي – دار المعرفة بيروت لبنان ط1/ 1986ص:1/ 209 وما بعدها بتصرف.
6 - "مقدمة ابن خلدون"، تحقيق خليل شحادة، ومراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت- 2001 - ص: 707
7 - المصدر نفسه، ص: 709.
8 - نفسه، ص: 709.
9 - نفسه، ص: 711، 712.
10 - نفسه، ص: 713.
11 - كتاب "مقال عن المنهاج" لرينيه ديكارت، ترجمة محمود محمد الخضيري، دار الكاتب العربي بالقاهرة، ط2/ 1968- ص: 109.
12 - "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" لابن رشد، دراسة وتحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، 1986م، ص: 22 وما بعدها.
13 - المصدر نفسه.
14 - كتاب "الفتوحات المكية" لابن عربي، ضبطه وصححه أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1/ 1999- 1/ 56، 57.
15 - المصدر نفسه، 1/ 56، 57.
16 - نفسه، 4/ 227، 228.
17 - كتاب "فصوص الحكم" لمحيي الدين بن عربي، شرح عبدالرزاق القاشاني، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1/ 2016- الفصل الأخير ص: 220.
18 - كتاب "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام" لعلي سامي النشار، دار المعارف بمصر، ط5/ 1971م- 1/231.
19 - للتوسع ينظر كتابه: "الفكر الإسلامي مواجهة حضارية". القسم الأول.
20 - للتوسع ينظر كتابه: "دراسات في الفلسفة الإسلامية".
21 - للتوسع ينظر كتابه: "أصول الفلسفة".
"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، دراسة وتحقيق محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، 1986م، ص22
تغريد









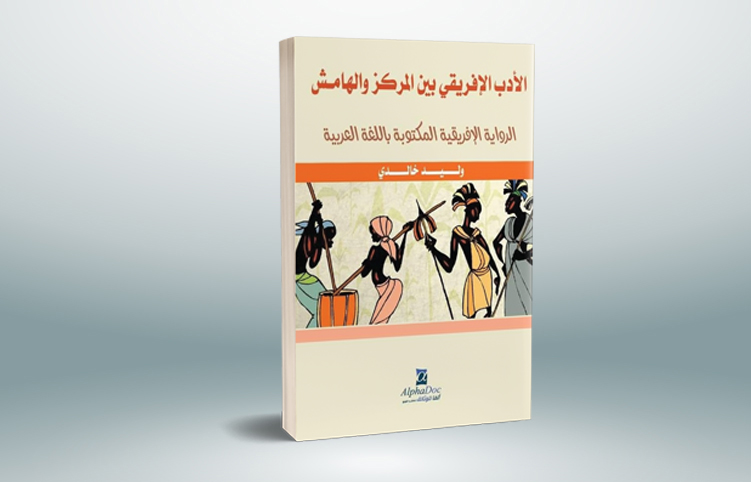








اكتب تعليقك